دائما المجتمعات الساكنة والجامدة ،تخاف من التغيير والتجديد. وهذا الخوف يتحول بفعل عمق الجمود والتكلس إلى رهاب. أي إلى مرض مجتمعي يحول دون أن ينفتح المجتمع على آفاق التغيير والتجديد وموجباتهما.
وفي هذا السياق تبرز المفارقة الصارخة ،التي تعيشها المجتمعات الجامدة. فهي تعيش التخلف والجمود والسكون على كل الأصعدة ،وتعتمد على غيرها من الأمم والمجتمعات في كل شيء ،وترضى بكل متواليات هذا الواقع السيء. وفي ذات الوقت تخاف التغيير ،وترفض التجديد ،وتقبل العيش في ظل هذا الواقع السيء ..
ولعلنا لا نبالغ حين القول: أن الخوف من التغيير والرهاب من التجديد ،ليس خاصا بمجتمع دون آخر ، وإنما هي من خصائص المجتمعات المتخلفة والجامدة ،بصرف النظر عن أيدلوجيتها وبيئتها .. فكل المجتمعات الجامدة تخاف من التغيير ،وكل الأمم المتخلفة تخشى من التجديد لمستوى الرهاب.
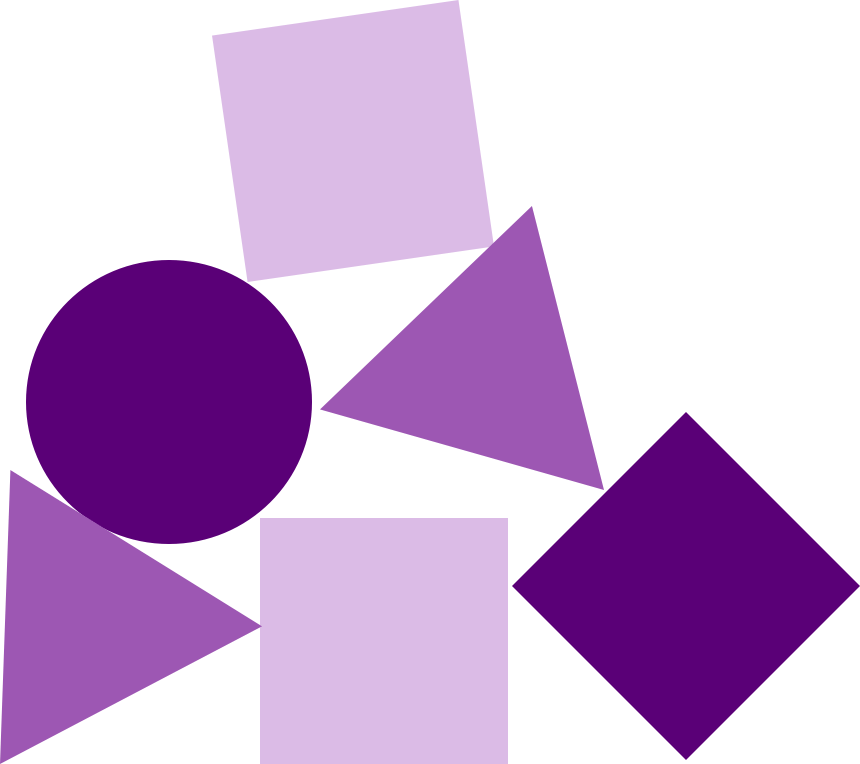
من هنا فإن لحظة الانطلاق الحقيقية في هذه المجتمعات ،تتشكل حينما تتجاوز هذه المجتمعات حالة الخوف والرهاب من التغيير والتجديد. فحينما يكسر المجتمع قيد الخوف من التغيير والتجديد ،حينذاك يبدأ المجتمع الحياة الحقيقية ،التي تمكنه من اجتراح فرادته وتجربته. أما المجتمعات التي لا تتمكن لأي سبب من الأسباب من تجاوز حالة الرهاب والموقف المرضي من التجديد ،فإنه سيستمر في التقهقر والتراجع على جميع الأصعدة والمستويات .. والفئات والشرائح التي لها مصلحة في استمرار التقهقر والجمود ،ستستثمر هذه الحالة المرضية وتبني عليها الكثير من المواقف والإجراءات ،والتي تعمق حالة التخلف وتزيد حالة الخوف المرضي من كل آفاق ومتطلبات التغيير والتجديد.
وينقل في هذا الصدد عن التاريخ الصيني القديم ،أنه في ظل سلالة هان (25 – 220 ب م ) صدر مرسوم إمبراطوري ينص على أنه لا يجوز لأي متأدب أن يطرق ،بصورة شفهية أو خطية ،أي موضوع لم يعينه له أستاذه. فليس يحق لكائن من كان أن يتخطى ميراث معلمه. وكل من تسول له نفسه أن يتعدى الحدود المرسومة يغدو مبتدعا.
وهكذا تأسس رهاب البدعة الذي شل قدرة المثقفين الصينيين على التفكير كما على التخيل. فلكأن عقولهم قد حبست في أكياس من البلاستيك حتى لا يتسرب إليها أي جديد.
فالنزوع القهري إلى رفض التغيير والخوف من التجديد ،هو حالة مرضية ،تزيد من انحطاط المجتمعات ، وتبقيها تحت ضغط الجمود والتخلف. ولا تقدم لهذه المجتمعات إلا بإنهاء حالة الرهاب من التغيير والتجديد ..ونحن هنا لا نقول أن التجديد في المجتمعات بلا صعوبات وبلا مشاكل ،ولكننا نود القول: أن مشاكل المجتمعات من فعل التغيير والتجديد أهون بكثير من استمرار حالة التخلف والجمود .. وإن المجتمعات لم تتقدم إلا حينما انخفض منسوب الخوف من التغيير والتجديد إلى حدوده الدنيا. بدون ذلك ستبقى مقولات التقدم والتجديد والتغيير ، مقولات جامدة ومنفصلة عن الحياة الاجتماعية.

وهذا ما يفسر لنا حالة بعض المجتمعات العربية والإسلامية على هذا الصعيد. فهي مجتمعات مليئة في الإطار النظري بمقولات التقدم والحرية والتجديد ، إلا أن واقعها الفعلي ،أي واقع النخب وأغلب الشرائح والفئات الاجتماعية ،تتوجس خيفة من هذه المقولات ،وتنسج علاقة مرضية مع مقتضيات التقدم والحرية والتجديد. فتجد الإنسان يصرخ ليل نهار باسم التغيير والتجديد ،إلا أنه في ذات الوقت يقف موقفا سلبيا من كل الوقائع الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تنسجم ومقولة التغيير والتجديد، فتتضخم لديه الخصوصيات إلى درجة إلغاء مقولة التجديد .. فهو باسم الثوابت يحارب المتغيرات ،وباسم الخصوصية يحارب التجديد ،وبعنوان عدم التماهي مع الآخر الحضاري يقف ضد كل نزعات التغيير والتجديد. فهو على الصعيد النظري ،جزء من مشروع الحل ،إلا أنه على الصعيد الواقعي ،جزء من المشكلة والمأزق. وكل ذلك بفعل رهاب التجديد والتغيير. وهي عناوين ومقولات لا يكفي التبجح بها ،وإنما من الضروري الالتزام النفسي والعقلي والسلوكي بمقتضياتهما ومتطلباتهما. وهنا حجر الزاوية في مشروعات التجديد في كل الأمم والمجتمعات ..
لهذا من الضروري لأي إنسان ومجتمع ،أن ينسج علاقات جدلية ونقدية مع مقولاته وشعاراته ،حتى لا تتحول هذه المقولات والشعارات إلى أقانيم مقدسة ،تحارب التجديد في العمق والجوهر ،وهي تتبناه في المظهر.
ويبدو من خلال التجارب الإنسانية المديدة ،أن المجتمعات تتمايز على هذا الصعيد في هذه المسألة ..فكل المجتمعات تصدح بضرورة التطوير والتجديد والتغيير ،إلا أن هناك مجتمعات تخاف حقيقة من التجديد ،لذلك فهي على الصعيد الواقعي تحارب كل ممارسة تجديدية. فالتمايز يكون بين المجتمعات ،بين مجتمعات ترفع شعار التجديد وتلتزم بكل مقتضياته ومتطلباته. ومجتمعات ترفع شعار التجديد دون الالتزام بكل المتطلبات. ولعل من أهم الأسباب لهذا التمايز بين القول والممارسة هو في الخوف من التجديد والرهاب من التغيير. صحيح أن هذه المجتمعات ترفع شعار التجديد ،إلا أنها على الصعيد النفسي والثقافي تخاف من المقتضيات والمتطلبات. فهي مع التجديد الذي لا يتعدى أن يكون شعارا فحسب ، أما التجديد الذي يتحول إلى مشروع عمل وبرامج عملية متكاملة ،فهي ترفضه وتخاف منه. وأي مجتمع لا يتحرر من رهاب التجديد ،فإنه لن يتمكن على المستوى الواقعي من الاستفادة من فرص الحياة ومكاسب الحضارة الحديثة.

ولكي تتحرر مجتمعاتنا من رهاب التجديد والتغيير ،من الضروري التأكيد على النقاط التالية:
- إن التجديد والتغيير في المجتمعات الإنسانية ،لا يحتاج فقط إلى توفر الشروط المعرفية والثقافية والسياسية ،وإنما من الضروري أن يضاف إلى هذه الشروط ، شرط الاستعداد النفسي والعملي لدفع ثمن ومتطلبات التجديد في الفضاء الاجتماعي. وبدون توفر هذا الشرط ،لن تتمكن المجتمعات من ولوج مضمار التجديد. لأن التجديد بحاجة إلى جهد إنساني متواصل ، واستعداد نفسي مستديم لإنتاج فعل التجديد والتغيير في الواقع الاجتماعي. والاستعداد النفسي الذي نقصده في هذا السياق ،ليس ادعاء يدعى ،وإنما هو ممارسة سلوكية ،تحتضن وتستوعب كل شروط التجديد ،وتعمل على تمثل وتجسيد متطلباته في الذات والواقع العام.
فطريق التجديد في مجتمعاتنا ،ليس معبدا أو سهلا ،وأمامه العديد من الصعوبات والمآزق ،وبدون الاستعداد النفسي والعملي لدفع ثمن التجديد والتغيير ، لن تتمكن مجتمعاتنا من القبض على حقيقة التجديد والتغيير. فالمطلوب دائما وأبدا ومن أجل الاستيعاب الدائم لمكاسب العصر والحضارة الحديثة ،هو توفر الجهد الإنساني الموازي لطموحاتنا وتطلعاتنا. وبدون ذلك ستصبح دعوات التجديد في أي حقل من حقول الحياة وكأنها حرثا في البحر. فعليه فإن التجديد في المجتمعات الإنسانية ، يتطلب وجود مجددين ،يجسدون قيم ومبادئ التجديد ،ويعملوا من أجل بناء حقائق ووقائع في الحياة الاجتماعية منسجمة وقضايا التجديد ومتطلباته.
- إن قانون التغيير والتجديد في المجتمعات الإنسانية ، لا يعتمد على قانون المفاجأة أو الصدفة ،وإنما على التراكم. فالتجديد يتطلب دائما ممارسة تراكمية ،بحيث تزداد وتتعمق عناصر التجديد في الواقع الاجتماعي. ولهذا ومن هذا المنطلق فنحن مع كل خطوة أو مبادرة صغيرة أو كبيرة ، تعمق خيار التجديد وتراكم من عناصره في الفضاء الاجتماعي. وفي المحصلة النهائية فإن التجديد هو ناتج نهائي لمجموع الخطوات والمبادرات والممارسات الايجابية في المجتمع.
ويشير إلى هذه الحقيقة المفكر العربي (جورج طرابيشي ) في كتابه (هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية ) بقوله: والواقع أن قانون الترابط بين حركة الإصلاح الديني والتقدم الثقافي دلل على فاعلية نموذجية في الدول الصغيرة الحجم في المقام الأول. وتلك هي حالة السويد التي كانت أول بلد في العالم يطور برنامجا شاملا لمحو الأمية. فانطلاقا من فكرة لوثر البسيطة القائلة إن جميع المسيحيين بلا استثناء كهنة ،وبما أن الكاهن هو بالتعريف في تصور بشر ما قبل الحداثة من يعرف القراءة ،بات واجبا على البشر ،كي يكونوا كهنة أي محض مسيحيين ،أن يتعلموا القراءة. وعلى العكس من الكنيسة الكاثوليكية التي عارضت وصول العامة إلى النصوص المقدسة ، شجعت الكنائس البروتستانتية أهالي المدن والأرياف على السواء على تعلم القراءة. ومنذ مطلع القرن السابع عشر أطلقت كنيسة السويد اللوثرية ،بمساندة من الدولة ،حملات واسعة النطاق لمحو الأمية. وفي أقل من قرن ،كان ثمانون في المئة من السكان ،في ذلك البلد القروي ،قد أضحوا من المتعلمين. وما إن أطل القرن الثامن عشر حتى كان تعميم التعليم في السويد قد أضحى ظاهرة جماهيرية ناجزة ،وهذا بدون وجود شبكة موازية من المدارس والأجهزة التربوية.
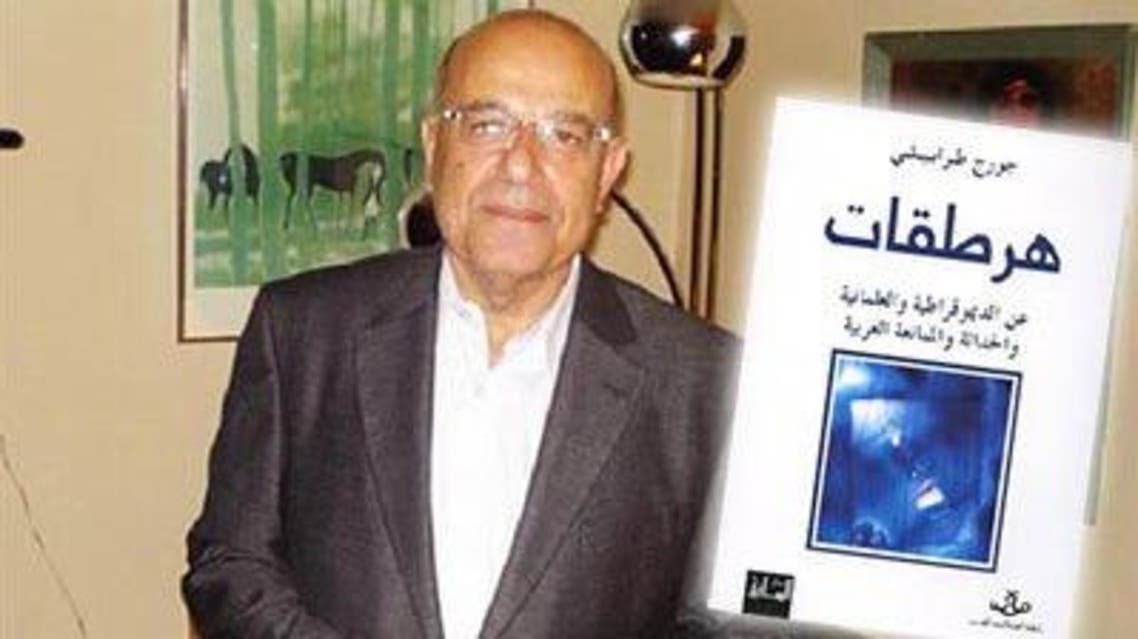
من خلال هذه التجربة نرى أهمية أن تترجم دعوات التجديد والتغيير إلى خطط وبرامج ومبادرات ،حتى يتسنى للمجتمع اكتشاف بركات ومنافع التجديد على المستويين الخاص والعام.
وجماع القول: أن التجديد في مجتمعاتنا ضرورة قصوى. ولكن هذا لا يعني أن طريق التجديد سالكا ومعبدا وبدون مشاكل ،بل على العكس من ذلك حيث أن طريق التجديد والتغيير مليء بالأشواك والصعاب. والشرط الضروري الذي يوفر لنا إمكانية تجاوز كل هذه العقبات وإبراز منافع التجديد والتغيير هو إنهاء حالة الرهاب والخوف من التجديد.
*الأستاذ محمد جاسم المحفوظ – مفكر وكاتب في الإنسانيات له العديد من المؤلفات والدراسات.
 علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية
علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية
