ما هو القرار؟ وما هي عملية اتخاذ القرار؟ لماذا نحتاج لاتخاذ قرارات؟
يعرّف علماء النفس والإدارة التنظيمية القرار على أنه عملية عقلية يقوم بها الفرد لينتج عنها تخصيص موارد معينة ومحدودة لإنجاز هدف محدد. وأما عملية اتخاذ القرار فهي العملية المعرفية التي يتم من خلالها اختيار من بين العديد من الخيارات الممكنة، وقد ينتج عن هذا الاختيار إصدار حكم قد يغيّر الوضع الحالي أو الإبقاء عليه كما هو. وتشمل هذه العملية تحديد الهدف المنشود تحقيقه، والبدائل الممكنة، وكذلك رسم الخطوط الحمراء أو القيود التي يجب الالتزام بها أثناء المفاضلة للخيارات المتاحة.

ويتوجب علينا اتخاذ القرار في المواقف التي تتوافر فيها ثلاثة عناصر، وهي:
- وجود هدف واضح متفق عليه لنحققه.
- الخيارات – “نقوم بالمفاضلة بينها”.
- عندما تكون الموارد محدودة تمنعنا من العمل على جميع الخيارات في آن واحد.
فعند غياب الهدف أو عدم وضوحه، لا يهم أبداً أيّ الخيارات نختار؟ ، وبأيها نبدأ؟ وإذا توفرت الموارد بشكل لامحدود، فبإمكاننا تقصي جميع الخيارات المتاحة في آن واحد دون الحاجة للمفاضلة فيما بينها. وكذلك إذا تم تحديث الهدف بوضوح، وتوفرت الموارد بشكل محدود، ولكن لم يكن لديك سوى خيار عملي واحد فقط لتحقيق الهدف، فلا يمكننا اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنّا سنتخذ هذا القرار أم لا. البعض منّا قد يعتبر عدم التصرف كأحد الخيارات الممكنة ولكن يجب الحذر من الوقوع في فخاخ التحيز عند القدوم بهذه الخطوة. في حين إذا توافرت جميع العناصر فيتوجب علينا اختيار أفضلها كي نصل للهدف بالطرق المثلى في دائرة القيود المرسومة.
لماذا يعتبر اتخاذ القرار عملية صعبة؟ وأين تكمن الصعوبة؟
تكمن صعوبة اتخاذ القرار في كونه أمر متعلق بالمستقبل وما يحيطه من غموض. فلا يمكن لأحد منّا أن يكون على يقين تام لما ستؤول إليه الأمور في المستقبل نتيجة القرار الذي عمل به. نعم، قد نملك بعض الأدوات التي تساعدنا لقراءة وتحليل الحقائق المتوفرة وبالتالي تساعدنا على رسم بعض الملامح المستقبلية، لكنها ستظل بعيدة عن درجة اليقين التام. أما الأمر الآخر فهو الفجوة المعرفية لدى متخذ القرار أو فريق العمل، حيث أن جهلنا أو عدم الإلمام الكافي بجوانب الموقف الذي أمامنا قد يلقي بظلاله على سير عملية التفكير المنطقية، وبالتالي تلقي هذه الفجوة بظلالها علينا على صورة الخوف من القدوم على اتخاذ القرار، فالإنسان بطبيعته عدو ما يجهل!
البديهية، الذكاء والتحليل النقدي
في مطلع القرن العشرين، ابتكر العالم الفرنسي ألفريد بينيه أول اختبار للذكاء وهو ما عُرف بـ (Intelligence Quotient – IQ) ليساعد الدولة الفرنسية في تحديد الطلاب الذين لا يستفيدون من برامج الدراسة العامة في فرنسا، وليتسنى للمؤسسة التعليمية تصميم البرامج اللازمة لمساعدتهم في رفع مستوياتهم. مرّ هذا الاختبار بالكثير من التعديلات ليصل إلى ما هو عليه اليوم حيث بات يُستخدم كمؤشر قياسي لتحديد مدى حدة ذكاء المرء. ومن هنا ساد الاعتقاد على وجود ترابط إيجابي بين مستوى ذكاء الإنسان في مؤشر الذكاء (IQ) وجودة القرارات التي يتخذها، بحيث يمكن قياس جودة القرارات من خلال معرفة مدى ذكاء الإنسان. ولكن الدراسات والملاحظات العلمية المتلاحقة قد فندت هذا الاعتقاد.

كان بول فرامبتون يمر بمرحلة صعبة بعد طلاقه وهو في سن الـ ٦٨، مما دفعه إلى تكوين صداقة عن طريق أحد مواقع التواصل على شبكة الإنترنت مع امرأة ادّعت أنها عارضة أزياء تشيكية مشهورة اسمها دينيس ميلاني. وقد استطاع بول من ترتيب موعد لقائهم الأول أثناء تواجدها في أمريكا الجنوبية لأحد أعمالها. ولكن وبعد وصول فرامبتون إلى بوليفيا، استاء بعدما عَلِم بأن ميلاني قد اضطرت لتغيير رحلتها من أجل عمل آخر، ولكنها طلبت منه أخذ حقيبة السفر التي نستها هناك. وفي طريق عودته، تم القبض على فرامبتون بتهمة تهريب كمية من الكوكايين في تلك الحقيبة. قد يتبادر إلى أذهاننا عند سماع هذه القصة أنها فخ درامي مقتبس من أفلام هوليوود وأن فرامبتون هذا هو شخص ساذج جداً. ولكن قدرات فرامبتون العقلية ليست ضعيفة كما نتصور، فهو عالم فيزياء مرموق وله مكانته في الوسط العلمي، وأبحاثه منشورة في الدوريات والمؤتمرات الدولية عن نظرية الأوتار ونظرية الحقل الكمي.
والكثير منا ربما قد سمع بشركة النفط الشهيرة “إنرون”، التي صُنفت في أوجها ضمن أكثر الشركات ابتكاراً في وقت كانت تصعد فيه شركات الالكترونيات والانترنت سلم النجومية في الابتكار. إلّا أن هذه الشركة سرعان ما تهاوت حتى أصبحت إسماً في صفحات التاريخ، ولتملئ عقول الناس بالدروس والسلوكيات التي لا يجب اتباعها لإدارة شركة ناجحة وذات سمعة. السبب؟ قرارات الإدارة التي كبدت الشركة والمستثمرين والموظفين الكثير من الخسائر. تلك الكارثة حدثت على الرغم من أن فريق الإدارة التنفيذية كانوا من خريجي الجامعات المرموقة ويعدّون من ضمن أفضل الإداريين التنفيذيين.
إن تفسير كيفية عمل دماغ الإنسان هو أمر أكثر من مجرد لغز محيّر. كيف يمكننا أن نكون بارعين جداً في بعض المهام، وجاهلين في أخرى؟ فبيتهوفن، على سبيل المثال، كتب سيمفونيته التاسعة بينما كان أصماً، في حين كان دائماً ما ينسى أين وضع مفاتيح منزله. فهل يمكن للناس أن يكونوا أذكياء وأغبياء في نفس الوقت؟ كيف يمكن ذلك؟ للإجابة على هذه التساؤلات، يجب علينا في البداية الوقوف قليلاً عند الكيفية التي يعمل بها الدماغ وآلية التفكير داخله.
بعد سنوات من الدراسات والأبحاث، توصل علماء النفس والأعصاب إلى اتفاق على المنهج الذي يساعدنا في الإجابة على هذه التساؤلات. ويرتكز هذا المنهج على التمييز بين نوعين من التفكير، كما يفسرها البروفسور دانيال كانمان، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد تقديراً لأبحاثه في هذا المجال والتي تعتبر حجر الأساس لتأسيس علم الاقتصاد السلوكي. الأول هو التفكير البديهي والتلقائي السريع، أو كما يشاع له بـ “النظام الأول”، والثاني هو التفكير التأملي والعقلاني – أو كما يشاع له بـ “النظام الثاني”.
يختزل النظام الأول خاصية التفكير بشكل كبير على باعتماده بديهية الشخص وتمرسه، كتصرفنا بتلقائية لتفادي الكرة عندما تقذف علينا. في المقابل، يكون النظام الثاني أكثر اتزاناً ووعياً، وهذا واضح عندما نريد حل معادلة رياضية. وبعبارة أخرى، يمكن تصور النظام التلقائي على أنه رد الفعل الغريزي، في حين أن النظام المتأني هو التفكير الواعي. وكما يوضح الباحثون، فإن الشعور الغريزي قد يكون دقيق إلى حد كبير في بعض المواقف التي تحتاج إلى سرعة بديهية، ولكن من الخطأ بمكان الاعتماد عليه بشكل كبير في تسيير أغلب قراراتنا.
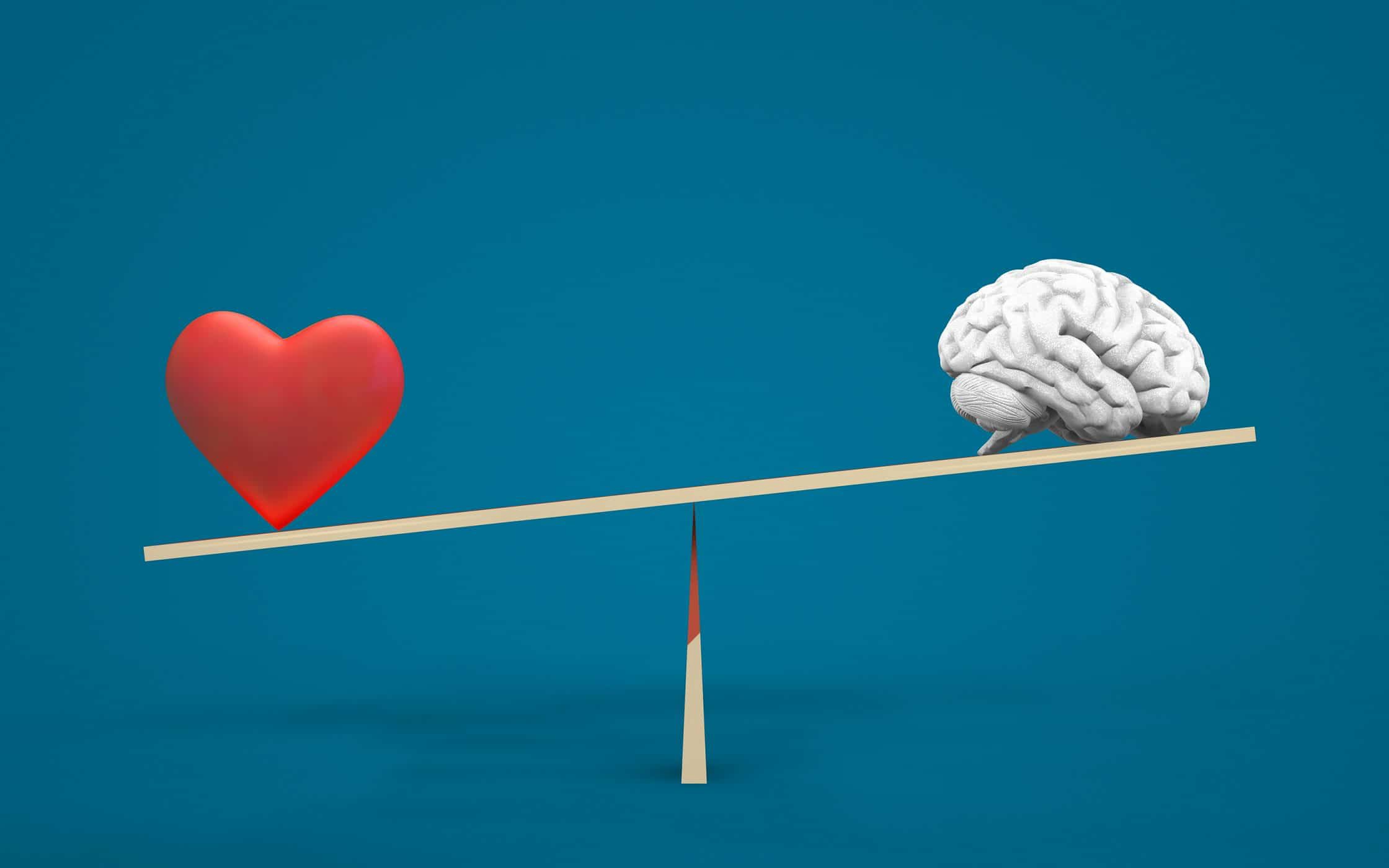
في مطلع العام ٢٠٠٩م، تمكن الكابتن تشيلسي سولبنرغر “سولي” من انقاذ جميع من كانوا على متن رحلة طيران الولايات المتحدة رقم ١٥٤٩ (١٥٥ راكباً بين مسافر وطاقم) في الحادثة الشهيرة التي وُصفت بالمعجزة. فبعد مرور أقل من ٣ دقائق على إقلاع الرحلة وتحليقها في سماء نيويورك، ارتطمت الطائرة بسربٍ من الطيور ما أفقدها كلا المحركين، وكذلك فقد مركز قمرة القيادة القدرة على التحكم بها، لتصبح الطائرة برمتها في حالة طوارئ لا تحسد عليها. وبعد التواصل مع برج المراقبة بمطار نيويورك لمعرفة الخيارات المتاحة لتنفيذ هبوط اضطراري في أحد المدرجات القريبة، سرعان ما تبين لسولي صعوبة الأخذ بالخيارات التي حددها برج المراقبة، وأعلن للجميع نيّته الهبوط في نهر هدسون من على ارتفاع بلغ ٣٢٠٠ قدم. هبطت الطائرة بنجاح على مياه النهر وتم انقاذ جميع من كانوا على متن الطائرة. في أول ردة فعل للمجلس الوطني لسلامة النقل، وجه انتقاده لتصرف الكابتن سولبنرغر، بعدما استنتج المجلس من نتائج التحقيقات الأولية بأن طاقم قمرة القيادة كان بإمكانهم معاودة التحليق والاتجاه إلى أحد المدرجات التي اقترحها برج المراقبة. إلا أن الطاقم، وعلى رأسهم سولي، دافع عن موقفه معللاً قراره بالهبوط في مياه النهر بأن حدساً قويّا قد انتابه في تلك اللحظة يحثه على ذلك لأنه الخيار الوحيد والأمثل، وكذلك لم تدع ضغوط الموقف والظروف المحيطة والوقت الضيق مجالاً للأخذ بالتوصيات الأخرى وأرواح الناس على المحك. واصل المجلس تحقيقاته، وقام بالعديد من تجارب المحاكاة للحادثة واختبار سيناريوهات مختلفة، اتضح للمجلس بأن قرار سولي كان هو القرار الصحيح. احتاج الكابتن سولبنرغر لسنوات من الطيران والخبرات والشجاعة الكافية ليثق ويتصرف بما يملي عليه حدسه وتلقائيته في مثل هذه المواقف.
بطبيعة حياتنا اليوم، أصبح المرء أكثر انشغالاً وحياتنا صارت أكثر تعقيداً نوعاً ما، ولذا لا يمكن وضع الكثير من الوقت والجهد في محاولة التفكير وتحليل الأشياء. وبهذا يصبح الجزء التلقائي من أدمغتنا هو الملجأ ويتمتع بالثقة العمياء دون إدراك منا. فنحاول بناء رصيدٍ من البديهيات – أو القواعد العامة – التي يمكن اللجوء إليها وقت الحاجة للبث في موقف ما. ومع تراكم هذه البديهيات وكثرة استخدامها دون تنقيح الموقف، نجد أنفسنا في متاهة تحيزات منظمة في الطريقة التي تعمل بها عملية التفكير المنطقي. هذه الرؤية التي طورها رائدي علم النفس دانيال كانمان وعاموس تفرسكي قد غيّرت نهج الباحثين في معني “التفكير”، وقد نتج عن أبحاثهما تحديد ثلاثة أنماط بديهية أو قواعد عامة وهي: الارتكاز، التوافر، والتمثيل، مما أدى إلى تعريف التحيزات المرتبطة بكل نمط.
الارتكاز هو محاولة إيجاد نقطة واستخدامها كمرجع لحل الموقف الذي أمامنا. فعندما تسأل عن عدد سكان مدينة لم تسمع بها من قبل ولكن ربما تكون قد زرت أو تعرف مدينة قريبة منها، فستكون هي الركيزة التي ستبدأ منها في محاولة تحديد عدد السكان.
أما نظرية التوافر، فهي تفسر كيف يقيس المرء إمكانية حدوث الكوارث وما إذا كان مستعداً في حال وقوعها، وما إذا كان عليه الاستعداد أم لا. وهذا يفسر سبب ترجيحنا لإمكانية حدوث المخاطر التي واجهتنا سابقاٌ أو الأحداث التي انتهت مؤخراً بنسب عالية تفوق ما تدل عليه الحقائق والأدلة. فبشكل عام يستشعر الإنسان بالخطر وإمكانية حدوثه بشكل مرتفع إذا خاض تجربة فيه، بغض النظر عن الظروف المحيطة بهذه التجربة. ويكون للأحداث المنتهية حديثاً تأثيراً أكثر على كيفية استشعاره بها في المستقبل. وهذا ما يفسر تهافت الناس لشراء بوليصات التأمين ضد حوادث الزلازل الأرضية مباشرة عقب حدوثها، ولكن سرعان ما تتناقص هذه المبيعات بعد مرور وقت على الحادثة.
أما البديهية الثالثة وهي التمثيل أو التشبيه وهي مرادف أقرب للنمطية. فمثلاً، نعتقد أن الأمريكي من الأصول الأمريكية طويل القامة على أنه محترف كرة سلة مقارنة بأمريكي من عرق آخر. هذا التمثيل قد تبلور من خلال رؤية الكثير من لاعبي كرة السلة في دوري المحترفين من ذلك العرق. تكمن خطورة هذه البديهية حينما تجبرنا على البحث عن أنماط في أي أمر عشوائي يمر علينا.

ولو رجعنا إلى سلوكيات فرامبتون وكذلك المدراء التنفيذيين في شركة إنرون، فهي ليست استثنائية كما يبدو للوهلة الأولى استناداً على النتائج السابقة. فهي تؤكد على وجود ارتباط وثيق بين معدل الذكاء بالعديد من النتائج المهمة في الحياة، كالنجاح الأكاديمي والأداء الوظيفي في العديد من أماكن العمل، ولكنه أقل دلالة حينما يكون الحديث عن القرارات الحكيمة والتفكير العقلاني النقدي، بما في ذلك القدرة على تقييم المخاطر والغموض والأدلة المتضاربة. بل ويذهب الكاتب ديفيد روبنسون في كتابه “فخ الذكاء” إلى أبعد من ذلك حيث أنه ناقش النظرية التي تقول أن الذكاء والخبرة قد يجعلونك أكثر عرضة للخطأ.
يرجع الاعتقاد على أن خصائص الذكاء هي مرتبطة ببعضها البعض إلى الدراسة التي نشرت في العام ١٩٠٤م في الدورية الأمريكية لعلم النفس للعام تشارلز سبيرمان. توصل سبيرمان لنتيجة أن أداء إحدى الوظائف الذهنية لها القابلية أن تكون على صلة بوظيفة أخرى، وقد أطلق على هذه الظاهرة بـ “التشعب الإيجابي”. وقد سيطر مفهوم هذه النظرية – إن صح التعبير – على سير الدراسات اللاحقة إلى أن جاءت دراسات عالم الإدراك في جامعة تورنتو الكندية البروفسور كيث ستانوفيش لتخالف هذا الاعتقاد.
ناقش ستانوفيش من خلال دراساته على إمكانية اختبار الذكاء قياس جوانب عديدة عن القدرة المعرفية للمرء، ولكن ليس من ضمن ذلك مستوى التفكير العقلاني. فهو يرى بأن اختبارات الذكاء في أحسن الأحوال يمكن أن تكون مؤشر معتدل عن مستوى التفكير العقلاني، وأن بعض مهارات التفكير العقلاني يمكن فصلها تماماً عن مؤشر الذكاء. ويصف الفرق بين الذكاء والعقلانية بـ “اللا تعقل” في إشارة إلى عدم قدرتنا على التصرف بعقلانية على الرغم من قدراتنا الذهنية بحسب مؤشر الذكاء. وأوصلته هذه النتائج إلى الحاجة لاستحداث معيار آخر يطلق عليه “معيار التفكير العقلاني” لقياس هذه المهارات الخاصة.
عمل واندي بروين دي براون من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة على تطوير مقياس الكفاءة في اتخاذ القرار لدى البالغين ليركز على المهارات الخاصة بهذه الإمكانية بدلاً من معيار الذكاء. كذلك بادر إيغور غروسمان من جامعة واترلو في كندا الرائد في دراسة الحكمة القائمة على الأدلة باختبارات في اتخاذ القرار بغرض استكشاف القدرة على إدراك الغموض المتأصل في الموقف بدلاً من التفكير بقيم دوغمائية مطلقة. كما قام أيضاً بقياس مستوى التواضع الفكري للمشاركين في تجاربه، أي إن اعترفوا بجهلهم وأظهروا رغبة في معرفة المزيد من المعلومات. وجاءت خلاصة النتائج التي توصل لها إيغور متناسقة مع مفهوم اللا تعقل، حيث أنها لم تقترن بالنقاط التي أفرزها في اختبارات الذكاء التقليدية. فقد وجد أن نتائج مؤشر الاستدلال الحكيم تميل إلى أن تكون أفضل في التنبؤ من نتائج معدل الذكاء.

هذه النتائج تتقاطع مع نظرية “العقلانية المحدودة” التي صاغها العالم هيربرت سيمون المتوج بجائزة نوبل عام ١٩٧٨م في الاقتصاد. وتصف هذه النظرية بأن عقلانية الفرد محدودة بالقيود المعرفية لدى الإنسان. ولهذا فإن الفرد لا يتبع التسلسل المنطقي كاملاً بل يختصره متبعاً طرقاً مختصرة، في محاولة إلى تعويض النقص المعرفي لديه مما قد يقوده في النهاية إلى اتخاذ قرارات غير مثالية. من هنا، فقد وضعت الدراسات الرائدة لدانيال كانمان وزملائه في سبعينيات القرن الماضي نقطة البداية لحقبة جديدة في محاولة فهم عملية التفكير في العقل البشري، وكيف يمكن تقويم مهارات الفرد في اتخاذ القرارات.
التحيزات المعرفية
التحيز المعرفي هو نمط منهجي للانحراف عن القاعدة السلوكية أو العقلانية في إصدار الأحكام والقرارات. وقد صاغ دانيال كانمان هذا المصطلح في العام ١٩٧٢م ضمن نتائج الدراسات والتجارب والملاحظات العلمية حول ضعف الناس في الحساب والرياضيات. تعتبر هذه الأبحاث علامة بارزة في تاريخ دراسة سلوكيات الأفراد وكيفية اتخاذهم القرارات. ولعل أبرز النظريات التي نتجت عنها تلك الدراسات هي كيف يمكن أن يتخذ الحكم البشري اختصارات استرشاديه بديهية تنحرف بشكل منهجي عن المبادئ الأساسية للاحتمالات؟. وتعتبر هذه الدراسات هي البذرة التي نشأ منها ما يعرف اليوم بالاقتصاد السلوكي الذي تمكنت نظرياته من الإجابة عن عدة تساؤلات جوهرية، على غرار كيف يمكن للأحكام التي تصدر في حالات عدم اليقين أن تكون بعيدة بشكل منهجي عن العقلانية المفترضة ضمن نطاق نظرية الاقتصاد التقليدي؟
أظهرت دراسة أجرتها عملاق الاستشارات “مكنزي” شملت أكثر من ١٠٠٠ مشروع استثمار تجاري كبير أنه عندما تقوم المؤسسات من الحد من تأثير التحيز في عمليات صنع القرار، فإنها قادرة على تحقيق عوائد تصل إلى سبع نقاط مئوية أعلى. وأنه:
- من الصعب أن يدرك الفرد التحيزات التي بنيت معه خلال السنوات. وإذا وجدها فإن النظام البديهي للعقل سيقوم بوضع السياق المناسب لتقبل الأمر كما هو عليه.
- (أيضاً، وخاصة في بيئة العمل)، يصعب على الرؤساء التنفيذيين السيطرة على تحيزاتهم، ولكن يمكنهم استغلال الطاقة والمهارة في الحد من التحيزات التي تلف فريق العمل كي يساعده على اتخاذ أفضل القرارات.
 علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية
علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية
