التاريخ نهر جار، يتدفق بعنفوان ، يسوق البشرية في منعطفات حادة، يجرعها كل الوان العذابات وإن استقام جرى بهم الهويده وأذاقهم من لحظات السعادة والهناء، لكنه نادراً ما يفعل لأن الإنسان ظلوم كفار.
 يتميز الإنسان بان له حضوران ، حضور في الطبيعة وهو فيها خاضع ومقهور بقوانينها ولا يختلف في هذا الحضور عن حضور الحيوان او النبات. و للإنسان حضور آخر ينفرد به عن غيره وهو حضور في التاريخ. وحده الإنسان يحضر في التاريخ، يصنع التاريخ كما أن التاريخ يصنعه. إنه حضور مقصور على الإنسان لما له من قدرة على التفكير والكلام وتغيير حياته وتسخير قوانين الطبيعة من أجل رفاهيته. كما أنه في بعده الروحي يملك إرادة يدير بها تناقضاته وصراعاته الداخلية و ينفتح بها على مسارات مختلفة لحياته. فإرادته الحرة تبني و تهدم، تخاصم و تسالم، تبسط يدها وتقبضها. إنه حضور يمكن الإنسان من صنع الحدث الذي يحول الزمان الكوزمولوجي – الطبيعي إلى زمان إنساني يحضر الماضي في الراهن بقوة، ويؤثر الراهن في المستقبل ، و من هنا يكون للتاريخ حركة ممتدة متصلة ، يتصل فيها ماضي الإنسان بحاضره و يشكل مستقبله. لا حركة للتاريخ في حياة الحيوان فماضيه وحاضره ومستقبله سيان. يعيش الحيوان في الزمان الكوزمولوجي (الطبيعي) فقط و ليس له زمانه الخاص.
يتميز الإنسان بان له حضوران ، حضور في الطبيعة وهو فيها خاضع ومقهور بقوانينها ولا يختلف في هذا الحضور عن حضور الحيوان او النبات. و للإنسان حضور آخر ينفرد به عن غيره وهو حضور في التاريخ. وحده الإنسان يحضر في التاريخ، يصنع التاريخ كما أن التاريخ يصنعه. إنه حضور مقصور على الإنسان لما له من قدرة على التفكير والكلام وتغيير حياته وتسخير قوانين الطبيعة من أجل رفاهيته. كما أنه في بعده الروحي يملك إرادة يدير بها تناقضاته وصراعاته الداخلية و ينفتح بها على مسارات مختلفة لحياته. فإرادته الحرة تبني و تهدم، تخاصم و تسالم، تبسط يدها وتقبضها. إنه حضور يمكن الإنسان من صنع الحدث الذي يحول الزمان الكوزمولوجي – الطبيعي إلى زمان إنساني يحضر الماضي في الراهن بقوة، ويؤثر الراهن في المستقبل ، و من هنا يكون للتاريخ حركة ممتدة متصلة ، يتصل فيها ماضي الإنسان بحاضره و يشكل مستقبله. لا حركة للتاريخ في حياة الحيوان فماضيه وحاضره ومستقبله سيان. يعيش الحيوان في الزمان الكوزمولوجي (الطبيعي) فقط و ليس له زمانه الخاص.
و إذا كان للتاريخ حركة متصلة في الزمان الإنساني الذي يلتحم فيه الماضي بالحاضر والمستقبل ، فلابد أن يكون هناك فعل من نوع معين، يمكن أن نسميه الفعل التاريخي، يسهم في حركة التاريخ، فليست كل أفعال الإنسان تصنع للتاريخ حركته. فالإنسان يأكل وينام ويمرض ويموت ويتزاوج لكن هذه أفعال بيلوجية – فيزيولوجية وليست أفعال تاريخية. إن الفعل الإنساني الذي يدخل في الحقل التاريخي ويصنع حدثا تاريخياً لابد أن يتميز عن غيره من الأفعال او الأحداث. فما هي محددات الحدث التاريخي الذي يصنع تموجاً أو اضطرابا في التاريخ؟ هذا التموج يبدأ من مركز الإضطراب و يتحرك مؤثرا في الأحداث من حوله و يستمر تأثيره في المستقبل. و بعض هذه التموجات ضخمة جداً بحيث تنفلت من أي سياق محرك للتاريخ و لكنها عبر مفاعيلها الروحية تحاول أن توجه حركة التاريخ لنهايته الحتمية.

لكن كي نتمكن من معرفة المحددات التاريخية للحدث الموصوف بالتاريخي علينا أن نتعرف على التأثيرات التي يتركها حدث ما تاريخي في إسباغ ديناميكية خاصة للتاريخ. فمن تعقب الأثر الذي يخلفه الحدث التاريخ نتمكن من وعي محدداته التاريخية ، فهل للأحداث التاريخية نتائج محددة ، أم لها تأثيرات عشوائية و ليس هناك ثمة قوانين خاصة تنتظم في سياقها التاريخي على غرار قوانين الطبيعة بحيث نعرف من خلالها نهايات محددة لهذه التموجات التاريخية. و إذا كان الجواب يعتمد على فهم السؤال فدعونا نستوضح السؤال من خلال هذه المقارنات بين الطبيعة والتاريخ ، فالإنسان يحضر في الإثنين معا. الإنسان محكوم ومقهور بقوانين الطبيعة ، فهل حضوره في التاريخ تحكمه قوانين ترسم مصيره ؟ بمعنى إذا كان التاريخ تصنعه أفعال الإنسان بمحدداتها التاريخية فهل لأفعاله عواقب حتمية ؟ وهل هذه العواقب هي نتاج منطق خاص يحكم الفعل التاريخي. و كما أن الإنسان يتعرف على قوانين الطبيعة و يسخرها من أجل العمران و بناء الحضارة ، فهل معرفة الإنسان بقوانين التاريخ تمكنه من معرفة مصيره في المستقبل؟ و هل هذه القوانين التاريخية تتناقض مع حرية الإنسان و اختياره؟ وما الفرق بين القوانين التي تحكم الإنسان في الطبيعة و تلك التي تحكمه في التاريخ؟
 الإجابة عن هذه التساؤلات تحدد وعينا بالتاريخ وعلاقتنا به. فإذا كان التاريخ مجموعة من الأحداث المتناثرة والعشوائية و تمارس تأثيراتها في الدائرة القريبة منها و لا يكون لها سلطة على المستقبل ، فمستقبل الإنسان تشكله إرادته بدون الحاجة لفهم التاريخ او العودة إلى الماضي. فهذا يجعل التاريخ محصورا في الماضي فقط والمعرفة به لا تعطي ثمرة الحاضر و لا تصنع ثمرة في المستقبل. أما إذا كان التاريخ له وحدة عضوية و تيار متصل يسير في مسارات محددة ، فكل خيار لنا يوجه هذا التيار في مسار محدد نحو مآلات محددة و محتومة ، فإن وعينا بالتاريخ له أهميته البالغة في توجيه مسارات الحركة في التاريخ نحو الوجهة التي نريد لها ان تكوّن مصيرنا المحتوم. بهذا يكون المستقبل يحدده الماضي و خيارات الحاضر ، و يشبه تماما المعادلات التحددية التي تمكن الفيزيائي مثلا من معرفة موقع جسم أو سرعته بناءً على معرفته بحالته الراهنه. يتحول التاريخ في وعينا إلى تاريخ علمي له قوانين تنظم مسيرة الإجتماع البشري ، و أنه لا يمكن بحال الإنفكاك عن قهارية هذه القوانين ، مما يجعل وعينا بالحدث التاريخي ضرورة لأنها تشكل مصيرنا. عندها يكون فهمنا للماضي ليس من باب الترف بل ضرورة لمعرفة أين يتحرك بنا التاريخ؟ و أين سيضعنا في المستقبل؟ و كيف نعمل على توجيه حركته في مسار مختلف؟ هنا يغدو التاريخ مصنعا ضخما يُصنع فيه مستقبلنا عبر مسارات تحركت في الماضي. إن لم نفهم كيف يعمل و كيف نؤثر فيه بحيث يأخذنا في المسار الآخر الذي نريد، والا فإن حتمية تاريخية ما ستقرر مصيرنا.
الإجابة عن هذه التساؤلات تحدد وعينا بالتاريخ وعلاقتنا به. فإذا كان التاريخ مجموعة من الأحداث المتناثرة والعشوائية و تمارس تأثيراتها في الدائرة القريبة منها و لا يكون لها سلطة على المستقبل ، فمستقبل الإنسان تشكله إرادته بدون الحاجة لفهم التاريخ او العودة إلى الماضي. فهذا يجعل التاريخ محصورا في الماضي فقط والمعرفة به لا تعطي ثمرة الحاضر و لا تصنع ثمرة في المستقبل. أما إذا كان التاريخ له وحدة عضوية و تيار متصل يسير في مسارات محددة ، فكل خيار لنا يوجه هذا التيار في مسار محدد نحو مآلات محددة و محتومة ، فإن وعينا بالتاريخ له أهميته البالغة في توجيه مسارات الحركة في التاريخ نحو الوجهة التي نريد لها ان تكوّن مصيرنا المحتوم. بهذا يكون المستقبل يحدده الماضي و خيارات الحاضر ، و يشبه تماما المعادلات التحددية التي تمكن الفيزيائي مثلا من معرفة موقع جسم أو سرعته بناءً على معرفته بحالته الراهنه. يتحول التاريخ في وعينا إلى تاريخ علمي له قوانين تنظم مسيرة الإجتماع البشري ، و أنه لا يمكن بحال الإنفكاك عن قهارية هذه القوانين ، مما يجعل وعينا بالحدث التاريخي ضرورة لأنها تشكل مصيرنا. عندها يكون فهمنا للماضي ليس من باب الترف بل ضرورة لمعرفة أين يتحرك بنا التاريخ؟ و أين سيضعنا في المستقبل؟ و كيف نعمل على توجيه حركته في مسار مختلف؟ هنا يغدو التاريخ مصنعا ضخما يُصنع فيه مستقبلنا عبر مسارات تحركت في الماضي. إن لم نفهم كيف يعمل و كيف نؤثر فيه بحيث يأخذنا في المسار الآخر الذي نريد، والا فإن حتمية تاريخية ما ستقرر مصيرنا.
محددات الفعل التاريخي
لم يهتدي الإنسان إلى قوانين خاصة في التاريخ، تتحكم في الإجتماع الإنساني وتقرر على ضوءها مصيره و مآلاته إلا مع القرآن الكريم. القرآن هو الكتاب الأول الذي فتح العقل الإنساني في آيات كثيرة صريحة ، واضحة عن وجود قوانين يطلق عليها القرآن سنن تحكم إجتماعه السياسي و الإقتصادي و الثقافي. بعد نزول القرآن بثماني قرون عمل إبن خلدون على فهم التاريخ فهما علمياً ، يضع التاريخ في مصاف العلوم الطبيعية ، له دوراته التاريخية تماما كدورة الماء في الطبيعة ( 1: ص332-333). فما هي الرؤية القرآنية لسنن التاريخ ؟ لنكتشف ، ولو بصورة موجزة ، من آيات القران المتناثره في سوره المختلفة هذه السنن التي يوصفها القرآن بانها لا تتبدل و لا تتحول. فسنن التاريخ – قوانينه – مضطردة ثابته تمتلك موضوعية و متى تحققت الشروط الموضوعية للحدث التاريخي فإنها تفضي دائما إلى نتائج محددة. فكما أن قوانين الطبيعة تمتلك ثباتاً و اضطراداً ، حيث تتحقق الظاهرة في الطبيعة كلما استوفت شروطها الموضوعية فكذلك تكون سنن التاريخ.
 يفرق القرآن بين وجود الإنسان كفرد و بين وجوده في المجموع ، جاعلا – القرآن – من المجموع البشري كائنا كبيرا له حياة و له موت و له حسابه الخاص. المجتمع كائن حي ينصهر الفرد فيه بالمجموع ، فيحاسب المجتمع على قرارته الجمعية وعلى سلوكه الجمعي. هكذا يعبر القرآن عن هذا الكائن الإجتماعي العملاق بأن له أجل ” لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ…” ( يونس :الاية 49) و حساب ” وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ” ( الجاثية: الاية 28)، ويعبر القرآن تعبيراً صريحاً عن وجود هذه السنن التي تحكم منطق التاريخ و أن على الإنسان أن يتتبع أحداث الماضين لاكتشافها لكي يتجنب مصير الماضين و يوجه بوصلة التاريخ نحو مستقبل افضل ” قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ” ( آل عمران: 137) . و قد أعطانا القرآن بعضا من هذه السنن ، فيخبرنا الله عز وجل في كتابه أن الإنتصار له شروطه الموضوعية ” وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ ” ( الانعام: الاية 34) و يرسم القرآن مستقبل الإنسان كفرد وفي المجموع بناءً على خياراته ، ليحمله مسؤولية مصيره ، فليس القضاء و القدر إلا ان يأخذ الإنسان و الكائن الإجتماعي قرار مستقبله عندما يحسم خياراته الداخلية ” ِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ” (الرعد: الاية 11) . مصير الأمة بيدها ، عليها أن تختار وعندما تختار فإن سنن الله في التاريخ تتحرك بها نحو مصيرها المحتوم و المقدر و الذي لا يمكن تحويله او تغييره. هذه السنن تجري على كافة المجتمعات و بدون إستثناء و لا يستثنى منها حتى الأنبياء والصالحون، يضرب الله لنا مثالا يخبرنا فيه عن النتيجة المحتومة لأمة من الأمم عندما تمارس فعلا ما ” ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّـهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ” (الانفال : الاية 53).(1: ص321-330)
يفرق القرآن بين وجود الإنسان كفرد و بين وجوده في المجموع ، جاعلا – القرآن – من المجموع البشري كائنا كبيرا له حياة و له موت و له حسابه الخاص. المجتمع كائن حي ينصهر الفرد فيه بالمجموع ، فيحاسب المجتمع على قرارته الجمعية وعلى سلوكه الجمعي. هكذا يعبر القرآن عن هذا الكائن الإجتماعي العملاق بأن له أجل ” لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ…” ( يونس :الاية 49) و حساب ” وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ” ( الجاثية: الاية 28)، ويعبر القرآن تعبيراً صريحاً عن وجود هذه السنن التي تحكم منطق التاريخ و أن على الإنسان أن يتتبع أحداث الماضين لاكتشافها لكي يتجنب مصير الماضين و يوجه بوصلة التاريخ نحو مستقبل افضل ” قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ” ( آل عمران: 137) . و قد أعطانا القرآن بعضا من هذه السنن ، فيخبرنا الله عز وجل في كتابه أن الإنتصار له شروطه الموضوعية ” وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ ” ( الانعام: الاية 34) و يرسم القرآن مستقبل الإنسان كفرد وفي المجموع بناءً على خياراته ، ليحمله مسؤولية مصيره ، فليس القضاء و القدر إلا ان يأخذ الإنسان و الكائن الإجتماعي قرار مستقبله عندما يحسم خياراته الداخلية ” ِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ” (الرعد: الاية 11) . مصير الأمة بيدها ، عليها أن تختار وعندما تختار فإن سنن الله في التاريخ تتحرك بها نحو مصيرها المحتوم و المقدر و الذي لا يمكن تحويله او تغييره. هذه السنن تجري على كافة المجتمعات و بدون إستثناء و لا يستثنى منها حتى الأنبياء والصالحون، يضرب الله لنا مثالا يخبرنا فيه عن النتيجة المحتومة لأمة من الأمم عندما تمارس فعلا ما ” ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّـهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ” (الانفال : الاية 53).(1: ص321-330)
القرآن الكريم يخبرنا عن سنن في التاريخ لكنها سنن تحكم نوعا خاصاً من الأحداث و ليست كل ما يجري في التاريخ. ليس كل حدث في التاريخ يصح أن نصفه بأنه فعلا تاريخيا يتصل فيه الماضي بالحاضر و المستقبل في وحدة عضوية. هذه السنن كما بين القرآن الكريم في بعض من هذه الآيات التي بيناها تأخذ مجراها فقط في أفعال المجموعة البشرية التي يكون حاضرها قد شكله الماضي و المستقبل يشكله الحاضر. فالله اخبرنا بأن علينا أن نعي تاريخ الماضين لنعتبر من مصيرهم و نرسم طريق مستقبلنا. و عندما نتأمل في آيات الله فإننا نستكشف أن من هنا يمكن لنا أن نتعرف على المحددات التاريخية للفعل التاريخي.
الحدث الحسيني و الدلالة الرمزية
تدخل الأخلاق في صميم البنية المكونه للإنسان ، فأفعال الإنسان دائماً تتحد بمعنى أخلاقي ، و هذا البعد الأخلاقي يضفي على الفعل الإنساني دلالة رمزية . فكما يصح ان نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق أو عاقل ، فيصح أيضا ان نعرفه بأنه حيوان رامز( 2: ص58). و الرامزية تتأتى من أن طبيعة الفعل الإنساني لا تنفك عن هوية اخلاقية معينة ، إذ هي دائما تشير إلى دلالات معينة في ثنائية الخير و الشر. و إن مستوى الرامزية هنا تعتمد على الكيفية التي يستجيب بها الإنسان للتحديات التي تدفع به للنشاط و التحرك. فكل تحدي يواجه الإنسان فهو في نفس الوقت تحدي أخلاقي ، لأن الإستجابة يمكن معايرتها بموازين الخير او الشر. و عظمة الرامزية تأتي من عظمة الإستجابة للتحدي الأخلاقي.

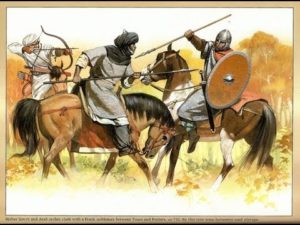

و الحدث الحسيني هو بهذا الإعتبار حدثا رامزاً بامتياز، له دلالاته الرمزية ، لكن دلالته تخطت السياق الثقافي و الحضاري العربي و الإسلامي ، و تحولت إلى رمزية كونية إذ يمتد تأثيرها إلى كل النطاقات الثقافية و الحضارية في العالم. ليست كل الأحداث التاريخية التي تستوفي المحددات التاريخية و تنطبق عليها سنن التاريخ هي احداث عميقة في مدلولها الرمزي. ففي التاريخ الإنساني حروب و صراعات صنعت تموجات في النسيج التاريخي لكنها تموجات تضعف و تخبو بالتدريج مع امتداد الزمان الطبيعي لتحل في ذاكرة التاريخ و يطويها النسيان و تفقد دلالتها الرمزية في الزمان الإنساني و لم يعد لها تأثير في حاضر الأمة أو مستقبلها. و بعض الأحداث تموجاتها كبيرة أشبه بالزلزال تسري تموجاتها في النسيج الإجتماعي التاريخي للأمة و يستمر تأثرها إلى أحقاب طويلة. و نحن بإزاء حدث – الحدث الحسيني – لا يزيده الزمان إلا حيوية و تجدد و عنفوان ، إنه حدث تجاوز التاريخ ليسكن الخلود ، و يعمل على توجيه الحراك التاريخي الإنساني بما يمتلكه من مفاعيل روحية و رامزية عظيمة نحو تحقيق الإنتصار التاريخي الإنساني للخير و العدالة. و ما كان له أن يكون كذلك إلا إنه توفر على شروط وضعته في هذه المكانة من التاريخ. و سنحاول ما وسعنا أن نحلل هذه المكانة التاريخية للحدث الحسيني لنفهم سر هذا التجدد و الحيوية و سر هذه الروح الساكنة فوق التاريخ و المحركه له.
 اولا : إن عظمة الحدث في التاريخ ترتبط بعظمة الشخصية التي يتمحور حولها الحدث. و محور الحدث هو الحسين بن علي عليهما السلام الإمام المعصوم. و سنتحدث هنا عن العصمة من مطلق الدائرة الخاصة للمذهب الإمامي و التي تستند إلى أدلتها من القرآن و الروايات و التي تعتبرها – العصمة – جزء من نظام التكوين ، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الكون و بنيته التي بها استقراره و استقامته. فكما يترتب على انعدام الشمس مثلا خراب الكون فكذلك يترتب على فقد الإمام المعصوم خراب الكون. و سنحاول بإيجاز ان نوضح للقارىء هذا المعنى المهم في التفسير الإمامي للعصمة. إن معنى أن يكون الإنسان قريب من الله هو أن يتشبه بأخلاق وصفات الله. فكلما كان الإنسان اكثر قربا من الله اصبح اكثر علما و قدرة …و اكثر كمالا. و بالتالي فإن للقرب الإلهي أثر تكويني ، فالقريب من الله له أثره في التصرف بالموجودات ، و كلما زاد الإنسان قربا أصبح له تأثير أوسع و أكبر ، وهذا ما يصطلح عليه بالولاية التكوينية. و بالعكس كلما كان الإنسان بعيداً عن الله تعالى كان اثره في نظام التكوين اقل. نحن نجد الروايات عند جميع الفرق الإسلامية تتحدث عن هذا المعنى بوضوح ، فمثلا في رواية قرب النوافل ” لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر ، ويده التي يبطش بها ” و في رواية قرب الفرائض ” إن العبد يكون يد الله و عين الله و سمع الله” يعني يكون العبد مظهرا لمشيئة الله الفعلية. و هناك عدد من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ما تؤكد أن وجود الإمام المعصوم في النظام الكوني ضرورة لاستمراره و بقاءه ، فعن الإمام الباقر عليه السلام ” لو أن الامام رفع من الأرض ساعة لساخت بأهلها و ماجت كما يموج البحر بأهله” ، و عنه عليه السلام ورد ايضا ” لو بقيت الأرض يوما واحد بلا إمام لساخت الارض بأهلها ، و لعذبهم الله بأشد عذابه ، و ذلك أن الله جعلنا حجة في أرضه و أمانا في الأرض لأهل الأرض ، لن يزالوا بأمان من أن تسيخ بهم الأرض ما دمنا بين أظهرهم ، فإذا أراد الله أن يهلكهم ثم لا يمهلهم و لا ينظرهم ، ذهب بنا من بينهم ، ثم يفعل الله بهم ما يشاء”.
اولا : إن عظمة الحدث في التاريخ ترتبط بعظمة الشخصية التي يتمحور حولها الحدث. و محور الحدث هو الحسين بن علي عليهما السلام الإمام المعصوم. و سنتحدث هنا عن العصمة من مطلق الدائرة الخاصة للمذهب الإمامي و التي تستند إلى أدلتها من القرآن و الروايات و التي تعتبرها – العصمة – جزء من نظام التكوين ، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الكون و بنيته التي بها استقراره و استقامته. فكما يترتب على انعدام الشمس مثلا خراب الكون فكذلك يترتب على فقد الإمام المعصوم خراب الكون. و سنحاول بإيجاز ان نوضح للقارىء هذا المعنى المهم في التفسير الإمامي للعصمة. إن معنى أن يكون الإنسان قريب من الله هو أن يتشبه بأخلاق وصفات الله. فكلما كان الإنسان اكثر قربا من الله اصبح اكثر علما و قدرة …و اكثر كمالا. و بالتالي فإن للقرب الإلهي أثر تكويني ، فالقريب من الله له أثره في التصرف بالموجودات ، و كلما زاد الإنسان قربا أصبح له تأثير أوسع و أكبر ، وهذا ما يصطلح عليه بالولاية التكوينية. و بالعكس كلما كان الإنسان بعيداً عن الله تعالى كان اثره في نظام التكوين اقل. نحن نجد الروايات عند جميع الفرق الإسلامية تتحدث عن هذا المعنى بوضوح ، فمثلا في رواية قرب النوافل ” لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر ، ويده التي يبطش بها ” و في رواية قرب الفرائض ” إن العبد يكون يد الله و عين الله و سمع الله” يعني يكون العبد مظهرا لمشيئة الله الفعلية. و هناك عدد من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ما تؤكد أن وجود الإمام المعصوم في النظام الكوني ضرورة لاستمراره و بقاءه ، فعن الإمام الباقر عليه السلام ” لو أن الامام رفع من الأرض ساعة لساخت بأهلها و ماجت كما يموج البحر بأهله” ، و عنه عليه السلام ورد ايضا ” لو بقيت الأرض يوما واحد بلا إمام لساخت الارض بأهلها ، و لعذبهم الله بأشد عذابه ، و ذلك أن الله جعلنا حجة في أرضه و أمانا في الأرض لأهل الأرض ، لن يزالوا بأمان من أن تسيخ بهم الأرض ما دمنا بين أظهرهم ، فإذا أراد الله أن يهلكهم ثم لا يمهلهم و لا ينظرهم ، ذهب بنا من بينهم ، ثم يفعل الله بهم ما يشاء”.
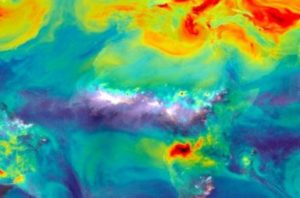 و من هذا المنظور يكون الحسين بن علي عليهما السلام الإمام الممثل لله على الأرض لأنه الأقرب الى الله في زمان إمامته و هو المظهر الحقيقي لأسماء الله و صفاته و بالتالي فإنه يحتل مكانه هامة في سلم الوجود الكوني ، و كل ما يدور حول شخصه من احداث يكون لها رمزيتها الهائلة لأن افعالها مظهر لمشيئة الله و تقع في اعلى درجات الكمال الأخلاقي.
و من هذا المنظور يكون الحسين بن علي عليهما السلام الإمام الممثل لله على الأرض لأنه الأقرب الى الله في زمان إمامته و هو المظهر الحقيقي لأسماء الله و صفاته و بالتالي فإنه يحتل مكانه هامة في سلم الوجود الكوني ، و كل ما يدور حول شخصه من احداث يكون لها رمزيتها الهائلة لأن افعالها مظهر لمشيئة الله و تقع في اعلى درجات الكمال الأخلاقي.
و ثانيا: الأحداث التاريخية ذات طبيعة رمزية كما أشرنا و رمزيتها تعطي الحدث التاريخي بقاءً و حيوية و لا يوجد تناقض بين رمزية الحدث و واقعيته. و هذه الدلالة الرمزية تفتح آفاق التأويل ‘ لأن التأويل هو الجهد المبذول لتفكيك رمزية الحدث. كما أن الرمزية هي افضل وسيلة لتمثل تجربة تاريخية ، و توحي بإمكانات مختلفة لعرض هذه التجربة في مسرودة تاريخية لها حبكتها تماما فكما للسرد الروائي حبكته التي تربط سير الأحداث و الشخصيات داخل الرواية. إنما يمتاز الحدث في الخطاب التاريخي السردي عن الروائي في أنه واقعي و في الآخر خيالي من إبداع الراوي. (3:ص26، 46،60-60-64) فالتاريخ عبارة عن قصص تحكى لكن الأحداث فيها واقعية و ليست من صنع الخيال. و السردية التاريخية للحدث الحسيني تتميز بحبكتها المتفردة حيث تطورت الأحداث في هذه الرواية الواقعية من بدايتها إلى نهايتها مرورا بمفاصل تشكل عقدا فيها بصورة تفتح فضاءً لا متناهياً من تمثل هذا الحدث في أنساق لسانية و بصرية و فنية لما له من طغيان هائل من الرمزية لن نبالغ إذا شبهناه بتسونامي ضخم يكتسح التاريخ ، و يمده بمفاعيل التغيير لصالح الخلاص الإنساني. دعونا إذن نتفهم الحدث من زاوية التحدي و الإستجابة و هي مفتاح الفهم التاريخي لدى المؤرخ الإنكليزي (ارنولد توينبي) الذي من خلالها أسس لرؤية عالمية لأسباب نشوء الحضارات و ازدهارها و من ثم تدهورها و سقوطها.
 شكّل يزيد تحديا خطيراً للأمة والإسلام و تكمن خطورته في إستغلال السلطة من أجل إفراغ الأمة من مضمونها الديني و إعادة تشكيل الوعي الديني و الثقافي على أساس أخلاق الطاعة و العبودية. فيصبح الناس عبيدا للحاكم المستبد و ليسوا عبيدا لله. يعني ان هذه الأمة مهددة بالموت من الداخل من خلال تعطيل و تغييب الفاعلية الدينية كما أسس لها رسول الله صلى الله عليه و آله. فهو في الخطورة يماثل السرطان الذي يقضي على الإنسان من الداخل و يتركه فريسة سهلة للموت. إذن نحن بإزاء تحدي يهدد الأمة في وجودها الثقافي و الحضاري و يعرضها للموت من الداخل. كان واجبا على الأمة أن تتحرك في مواجهة هذا التحدي و ان يولِد هذا التحدي الكبير فيها روح الإستجابة السريعة للحفاظ على المنجز الحضاري و الثقافي للأمة. لكنها لم تستجب و اتخذت موقف الصمت و التسليم. و من موقف الصمت و الخذلان أخذت سنن الله الحاكمة في التاريخ مجراها و أورثت الأمة حروبا و انقسامات و ضياع و تشتت. و لنا كذلك أن نحيل السر في أزماتنا الراهنة إلى صمت الأمة في ذلك الحين او إستسلامها لخنجر يزيد و سوطه حيث رسخ فيها ان الحاكم هو قدر الله لهذه الأمة و أن عليها ان تقبل بما أراده الله لها. كان لابد للإمام الحسين الذي يعرف مكمن الخطورة في تولي أمر الأمة راع مثل يزيد ان يستجيب و إن لاذت الامة إلى الصمت لأن الصمت يعني موت الأمة و القضاء على الرسالة. و لكن الإستجابة لابد ان تكون بطريقة خاصة بحيث تبقي رسالة الإسلام حية في ضمير الأمة و إن تسلط عليها الطغاة. و تطور الأحداث في هذه المأساة يشي بفرادة الإستجابة الحسينية ، و قدرتها على إدارة الحدث برمته من أجل أن تبقى رسالة جده صلى الله عليه و آله حية في الضمير و الوعي الجمعي للأمة. لذلك كان الحدث يسكن القلوب و ليس التاريخ ، فكانت مصدرا للأمة يمدها بالحياة و العزة كلما غالبها غالب أو قهرها قاهر. و عند استعراض تفاصيل الحدث الحسيني و التأمل فيه سندرك الفرادة على كافة المستويات كاشفة عن افق ممتد لا نهائي من الدلالات. فهناك فرادة على مستوى شخصيات الحدث و فرادة على المستوى التراجيدي و فرادة على المستوى الأخلاقي …فرادة تلهم الإنسان أن يعود إلى كربلاء ليرتشف من نبعها الصافي ما يضفي لحياته معنى يقف وراء أسوار المادة و قيود الظالمين ، إنها تحيلنا إلى معاني لا تتوقف.
شكّل يزيد تحديا خطيراً للأمة والإسلام و تكمن خطورته في إستغلال السلطة من أجل إفراغ الأمة من مضمونها الديني و إعادة تشكيل الوعي الديني و الثقافي على أساس أخلاق الطاعة و العبودية. فيصبح الناس عبيدا للحاكم المستبد و ليسوا عبيدا لله. يعني ان هذه الأمة مهددة بالموت من الداخل من خلال تعطيل و تغييب الفاعلية الدينية كما أسس لها رسول الله صلى الله عليه و آله. فهو في الخطورة يماثل السرطان الذي يقضي على الإنسان من الداخل و يتركه فريسة سهلة للموت. إذن نحن بإزاء تحدي يهدد الأمة في وجودها الثقافي و الحضاري و يعرضها للموت من الداخل. كان واجبا على الأمة أن تتحرك في مواجهة هذا التحدي و ان يولِد هذا التحدي الكبير فيها روح الإستجابة السريعة للحفاظ على المنجز الحضاري و الثقافي للأمة. لكنها لم تستجب و اتخذت موقف الصمت و التسليم. و من موقف الصمت و الخذلان أخذت سنن الله الحاكمة في التاريخ مجراها و أورثت الأمة حروبا و انقسامات و ضياع و تشتت. و لنا كذلك أن نحيل السر في أزماتنا الراهنة إلى صمت الأمة في ذلك الحين او إستسلامها لخنجر يزيد و سوطه حيث رسخ فيها ان الحاكم هو قدر الله لهذه الأمة و أن عليها ان تقبل بما أراده الله لها. كان لابد للإمام الحسين الذي يعرف مكمن الخطورة في تولي أمر الأمة راع مثل يزيد ان يستجيب و إن لاذت الامة إلى الصمت لأن الصمت يعني موت الأمة و القضاء على الرسالة. و لكن الإستجابة لابد ان تكون بطريقة خاصة بحيث تبقي رسالة الإسلام حية في ضمير الأمة و إن تسلط عليها الطغاة. و تطور الأحداث في هذه المأساة يشي بفرادة الإستجابة الحسينية ، و قدرتها على إدارة الحدث برمته من أجل أن تبقى رسالة جده صلى الله عليه و آله حية في الضمير و الوعي الجمعي للأمة. لذلك كان الحدث يسكن القلوب و ليس التاريخ ، فكانت مصدرا للأمة يمدها بالحياة و العزة كلما غالبها غالب أو قهرها قاهر. و عند استعراض تفاصيل الحدث الحسيني و التأمل فيه سندرك الفرادة على كافة المستويات كاشفة عن افق ممتد لا نهائي من الدلالات. فهناك فرادة على مستوى شخصيات الحدث و فرادة على المستوى التراجيدي و فرادة على المستوى الأخلاقي …فرادة تلهم الإنسان أن يعود إلى كربلاء ليرتشف من نبعها الصافي ما يضفي لحياته معنى يقف وراء أسوار المادة و قيود الظالمين ، إنها تحيلنا إلى معاني لا تتوقف.
الحدث الحسيني خالد في الشعور الإنساني ، ما بقي إنسان على الأرض ينشد الحق و العدل ، و هو خالد ايضا في الشعور الديني قال رسول لله صلى الله عليه و آله” إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا”. و مادام الحدث الحسيني بهذه الأهمية في الوعي الإنساني الحقوقي ، فهل ستكون لهذا الحدث إمكانات الإنتصار و التحقق؟ هل لمفاعيله الروحية أن تقود سفينة البشرية و ترسيها في الشاطئ الذي فيه خلاص البشرية من الظلم و الظالمين؟ هل من حتمية تاريخية لانتصار الحق و زوال الظلم من وجه الأرض؟
الحدث الحسيني و حتمية التجلي و الإنتصار
إنقسم الفلاسفة حول الحتمية التاريخية أي أن يكون للتاريخ الإنساني مسار يؤدي إلى نتيجة معينة. في مقابل الحتمية التاريخية توجد حتمية التغير وعدم الثبات والتدفق المستمر بحيث يستحيل علينا أن نقول شيئا محدداً عن المصير النهائي للتاريخ. حتمية التغير هي رؤية كونية للشأن الإنساني في فلسفة هرقليطس حيث يغدو المصير الإنساني غير قابل للتحديد. لا شك فإن هذه الرؤية تصيب الإنسانية بقلق بالغ حول مستقبلها ، فما كان من أفلاطون الذي آمن بعالم المثل الثابت ، أن يضع مصيرا مشابها للإنسانية في عالمها المادي تتخلص فيه من الفساد و الإنحلال الذي طال كافة شئوون الحياة و ذلك عن طريق التعقل الكامل للعلل: الفساد و العمل على وضع برنامجا عقليا يزيل آثار الفساد و يحقق للإنسانية حلمها في العدالة و السعادة فكانت مدينته المثالية. ينظر الفيلسوف الإلماني الكبير هيغل الذي تعد فلسفته الأكثر تاثيراً في القرن التاسع عشر إلى مسيرة التاريخ على أنها مسيرة تطور العقل. و أن التاريخ الإنساني هو عبارة عن جدلية ديالكتيكية بين المادة و العقل و سينتصر العقل في التاريخ و يحكم سيطرته على العالم. إعتقد ماركس بمسار حتمي للتاريخ ينتهي بزوال الطبقة الرأسمالية و تحقق الشيوعية في العالم كهدف نهائي لحركة التاريخ.
 يرفض كارل بوبر في كتابه “المجتمع المفتوح و أعداءه” ما يصطلح عليه بالمداخلة اليوتيوبية أو الهندسة اليوتيوبية. و مقصوده من المداخلة اليوتيوبية في حقل النشاط السياسي أن يكون لدينا هدف سياسي نهائي يتم من خلاله تحديد برنامج عملي للوصول اليه. قد تبدو كما يقول بوبر هذه المداخلة جذابة و مقنعة خصوصا لهؤلاء الذين تجذبهم الأفكار المسبقة و التي تختزل تجارب البشرية في إتجاه نهائي. يرى بوبر ان المجتمع المغلق هو الذي يحدد بداية و نهاية للتاريخ ، و ينظر إلى هذا التحديد النهائي للتاريخ وفق برنامج سياسي عملي يتم من خلاله توجيه المسار السياسي نحو هدف نهائي و كبير من أجل تحقيق دولة مثالية ، على انها محاولة يوتيوبية ، و ستؤدي إلى ديكتاتورية (4، ص259-263). و يضع بوبر عدد من القضايا هي بمثابة ركائز في نقد الحتمية التاريخية. فهو يقرر ان مسيرة التاريخ تتأثر بنمو المعرفة البشرية. و بما أننا لا نستطيع التنبؤ بالطريقة التي تنمو بها أفكارنا فإنه كذلك لا يمكننا التنبؤ بمستقبل المسيرة التاريخية. و بالتالي فإنه لا يمكن ان تكون هناك نظرية علمية في تفسير التاريخ على أساس التنبؤ. ( 5 ، ص 190)
يرفض كارل بوبر في كتابه “المجتمع المفتوح و أعداءه” ما يصطلح عليه بالمداخلة اليوتيوبية أو الهندسة اليوتيوبية. و مقصوده من المداخلة اليوتيوبية في حقل النشاط السياسي أن يكون لدينا هدف سياسي نهائي يتم من خلاله تحديد برنامج عملي للوصول اليه. قد تبدو كما يقول بوبر هذه المداخلة جذابة و مقنعة خصوصا لهؤلاء الذين تجذبهم الأفكار المسبقة و التي تختزل تجارب البشرية في إتجاه نهائي. يرى بوبر ان المجتمع المغلق هو الذي يحدد بداية و نهاية للتاريخ ، و ينظر إلى هذا التحديد النهائي للتاريخ وفق برنامج سياسي عملي يتم من خلاله توجيه المسار السياسي نحو هدف نهائي و كبير من أجل تحقيق دولة مثالية ، على انها محاولة يوتيوبية ، و ستؤدي إلى ديكتاتورية (4، ص259-263). و يضع بوبر عدد من القضايا هي بمثابة ركائز في نقد الحتمية التاريخية. فهو يقرر ان مسيرة التاريخ تتأثر بنمو المعرفة البشرية. و بما أننا لا نستطيع التنبؤ بالطريقة التي تنمو بها أفكارنا فإنه كذلك لا يمكننا التنبؤ بمستقبل المسيرة التاريخية. و بالتالي فإنه لا يمكن ان تكون هناك نظرية علمية في تفسير التاريخ على أساس التنبؤ. ( 5 ، ص 190)
إن رفض كارل بوبر لرؤية كونية لمسار التاريخ بناءً على عدم قدرتنا على الإحاطة التامة بمستقبل تطور الفكر البشري الذي هو عامل مؤثر لمسيرة التاريخ لهو كلام دقيق يصدرعن فيلسوف ذو منهجية نقدية عالية و يتمتع بإستقلالية ، لا يتاثر بالأفكار السائدة و هو جدير بالإحترام. و لكن دعونا نضيف عنصرا مهما و مؤثرا في مسيرة التاريخ و يدعم مناقشة بوبر الرافضة للحتميات التاريخية وهو العنصر الأخلاقي. الأخلاق هي الجانب المعنوي في حياة الإنسان و كل عمل تاريخي كما أسلفنا له بعده الأخلاقي. فلو افترضنا اننا استطعنا أن نحيط علماً بتطور المعرفة البشرية فإن ذلك لا يكفي للتنبؤ بمستقبل المسيرة التاريخية ، لإننا لا نستطيع أن نتنبأ كذلك بالموقف العملي و الفلسفي الأخلاقي العام لمن يباشر الفعل السياسي ، وبالتالي فإن هذا يجعل من التفسير العلمي للتاريخ معقداً جدا. فمثلا بعد أن سادت العقلانية المجتمعات الأوروبية ، ظهرت النازية ذات التوجه العنصري و اشعلت فتيل الحرب في أوروبا و قضت على منجزات التنوير و الأمل في أن تكون العقلانية العلمية الفلسفية المستقلة عن الدين مصدرا لسعادة البشرية.

و الحقيقة لو كان الموقف العقدي المعتزلي صحيحاً في مسألة استقلال العبد في أفعاله عن الله ، حيث تعتقد المعتزلة أو قسما منهم أن فعال العباد قد فوضها الله اليهم ، لكانت رؤية كارل بوبر على درجة عالية من الصحة. لكن النصوص الصريحة في القرآن و الروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام لا تدع لنا مجالا للحياد في مسألة حتمية معينة للتاريخ الإنساني.
ينبغي أن ندرك أن مسيرة الإنسان في التاريخ تحيطها العناية الإلهية ، فلم يخلق الإنسان ليضيع في متاهات الحياة دون أن يعي الرسالة التي من أجلها خلق و إلا لأصبح الخلق عبثا و بدون حكمة. و من هنا ندرك خطأ المعتزلة في معتقدهم المتمثل باستقلال الخلق عن الخالق ، لأن الله لطيف بعباده و من مقتضى هذا اللطف يحيطهم بعنايته و يوجههم باتجاه الهدف الذي من أجله قامت السموات و الأرض و إلا للزم من ذلك نقض الغرض. و إذا ما استعرنا بالفلسفة لوصف الغاية النهائية لحركة التاريخ فإنه يمكن القول بان التاريخ يملك استعدادا إمكانيا للتفتح عن ثمرة نهائية تقطفها الإنسانية بعد مسيرة العذابات و الظلامات في مزالق التاريخ الوعرة و التي قذفت بالإنسانية في متاهات التشتت و الضياع ، تماما كما تملك البذرة امكانا استعداديا لتصبح ثمرة بعد مسار طبيعي خاص وفق شروط موضوعية خاصة. و من مظاهر العناية الإلهية بهذا العالم هو أولا أن هذا الكون خلق على النظام الأحسن ” الذي احسن كل شيء خلقه” و إلا لتنافى ذلك مع كمال الله و علم الله و حكمة الله. و ثانيا أنه لا توجد استقلالية تامة للقوانين الطبيعية و التاريخية. لأن العلاقة بين الأثر و المؤثر او السبب و المسبب و إن كانت ضرورية هي علاقة جعلية من الله تعالى و ليست ناشئة من نفسها و اقتضاء ذاتها. ( 6 ، ص25-29 ) النظام العلي في الكون هو نظام جعلي فترتب السبب على المسبب ليس ترتبا ذاتيا و إنما بجعل من الله. و هذا ما يجعلنا لا نحيد في مسألة حتمية معينة لحركة التاريخ يتجلى فيها الحق و ينبلج كالصباح عندما يشرق بنور الشمس.
 و بتتبع النصوص القرآنية نجد أن هناك حتمية ينتصر فيها الحق على الباطل ، نطلق عليها حتمية الإنتصار. ففي القرآن الكريم عدد من الآيات التي تعطي وعدا من الله للمؤمنين بالإنتصار النهائي و الإستخلاف . و الوعد الإلهي قضاء مبرم و ليس فيه تغيير ، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز واصفاً وعده بالتحقق ” وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ …” (الانبياء :104) و قوله عز من قائل ” إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ” ( مريم:61) لنستعرض بعضا من هذه الآيات التي تشير إلى حتمية الإنتصار. يقول الله تعالى ” وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ” ( الصافات : 171-172) و يقول ايضاً ” وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ” ( النور: 55)
و بتتبع النصوص القرآنية نجد أن هناك حتمية ينتصر فيها الحق على الباطل ، نطلق عليها حتمية الإنتصار. ففي القرآن الكريم عدد من الآيات التي تعطي وعدا من الله للمؤمنين بالإنتصار النهائي و الإستخلاف . و الوعد الإلهي قضاء مبرم و ليس فيه تغيير ، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز واصفاً وعده بالتحقق ” وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ …” (الانبياء :104) و قوله عز من قائل ” إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ” ( مريم:61) لنستعرض بعضا من هذه الآيات التي تشير إلى حتمية الإنتصار. يقول الله تعالى ” وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ” ( الصافات : 171-172) و يقول ايضاً ” وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ” ( النور: 55)
و هناك غاية أخرى لحركة التاريخ يستعرضها القرآن في جملة من آياته ، نطلق عليها حتمية التجلي ‘ حيث تتجلى صفات الله لمخلوقاته فيدركون عظمته ، و كمال قدرته و علمه. يقول الله عز وجل ” اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّـهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ” ( الطلاق: 12) و يقول ايضا ” سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ” (فصلت: 53)
 ولاشك أن الحدث الحسيني بما يمتلكه من مفاعيل روحية هائلة و يختزن إمكانات التحقق عبر توجيه بوصلة الحركة التاريخية نحو حتمية الإنتصار و التجلي. و كما أشرنا بأن مسيرة التاريخ ترعاها العناية الإلهية و لا يمكن أن نلتزم برؤية تفسيرية للتاريخ تستبعد الدور الإلهي في الإنتصار للحق و تجلي صفات الله للخلقه ، إذ هو الهدف الحقيقي من الخلق أن يتعرف الخلق عليه. الحتمية التاريخية بدون أن تتضمن العنصر الرباني ستؤدي إلى شمولية تحطم الإنسان كما برهنت على ذلك تجربة الإنسان في التاريخ. أما إذا أضفنا البعد الرباني فإن ذلك يمنح الإنسان الثقة والأمل بانتصار الحق و تجليه.
ولاشك أن الحدث الحسيني بما يمتلكه من مفاعيل روحية هائلة و يختزن إمكانات التحقق عبر توجيه بوصلة الحركة التاريخية نحو حتمية الإنتصار و التجلي. و كما أشرنا بأن مسيرة التاريخ ترعاها العناية الإلهية و لا يمكن أن نلتزم برؤية تفسيرية للتاريخ تستبعد الدور الإلهي في الإنتصار للحق و تجلي صفات الله للخلقه ، إذ هو الهدف الحقيقي من الخلق أن يتعرف الخلق عليه. الحتمية التاريخية بدون أن تتضمن العنصر الرباني ستؤدي إلى شمولية تحطم الإنسان كما برهنت على ذلك تجربة الإنسان في التاريخ. أما إذا أضفنا البعد الرباني فإن ذلك يمنح الإنسان الثقة والأمل بانتصار الحق و تجليه.
المراجع
1-المجتمع و التاريخ ، المفكر الاسلامي الكبير الشهيد مرتضى المطهري، دار المرتضى بيروت، 1988.
2- علامات فارقة في الفلسفة و اللغة و الادب، أحمد يوسف، منشورات ضفاف، الطبعة الاولى2013 .
3- السرد التاريخي عند بول ريكور، جنات بلخن، منشورات ضفاف ، الطبعة الاولى 2014.
4- المجتمع المفتوح و اعداؤه ، كارل بوبر ، ترجمة السيد نفادي، التنوير للطباعة و النشر ، الطبعة الاولى 2014.
5- الفلسفة السياسية ، د علي عبود المحمداوي ، منشورات ضفاف ، الطبعة الاولى 2015.
6- الولاية التكوينية حقيقتها و مظاهرها ، السيد كمال الحيدري ، بقلم الشيخ علي حمود العبادي ، دار القارىء ، الطبعة الاولى 2010.
 علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية
علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية
