الإستقراء الناقص هو أحد الأدلة التي يمارسها العقل و يراد به كل إستدلال تكون نتيجته أكبر من المقدمات المكونة لتلك النتيجة. في الإستقراء التام تأتي النتيجة مساوية للمقدمات ، ولكن في هذا النوع من الإستقراء يتم القفز من مقدمات محدودة تم إستقصائها إلى نتيجة عامة تفيد العلم بقضية ما. فمثلا النتيجة التي خلصت اليها التجارب من أن الحديد يتمدد بالحرارة لم تتكون على أساس إستقصاء كل الحديد في هذا الكون ولكن يستطيع الإنسان أن يجزم بهذه الحقيقة ويعممها لكل الحديد على أساس إستقصاء عدد محدود منها.
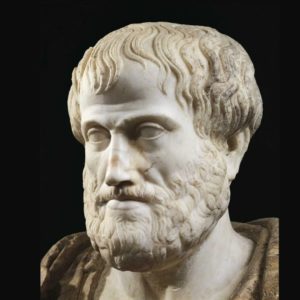 النقطة الأساسية هي كيف نبرر منطقياً التعميم أي القفز من الخاص إلى العام بحيث يصبح الإستقراء الناقص مفيداً للعلم بقضية ما. وفي الوقت الذي يحاول المنطق الأرسطي أن يصل إلى المبرر المنطقي الذي يمد جسور الإتصال بين الخاص والعام ويعطي للتعميم قيمته العلمية يؤكد أن الإستقراء الناقص بنفسه لا يمتلك هذا التبرير لأنه مجرد تجمع عددي للشواهد. فإذا إستطعنا أن نكشف عن رابط يشد هذه القضايا المشمولة بالإستقراء بعضها ببعض ويجعل أحدها (أ على سبيل المثال) سبباً في وجود الآخر (ب) أو أن عدم (أ) سبب لعدم (ب) فإننا نستطيع حينئذ أن نبرر هذا التعميم ونمد جسر الإتصال بين الخاص والعام ونصل في نهاية المطاف إلى العلم الجازم بقضية ما. فكيف إستطاع المنطق الأرسطي أن يجعل من الإستقراء الناقص مفيداً للعلم؟
النقطة الأساسية هي كيف نبرر منطقياً التعميم أي القفز من الخاص إلى العام بحيث يصبح الإستقراء الناقص مفيداً للعلم بقضية ما. وفي الوقت الذي يحاول المنطق الأرسطي أن يصل إلى المبرر المنطقي الذي يمد جسور الإتصال بين الخاص والعام ويعطي للتعميم قيمته العلمية يؤكد أن الإستقراء الناقص بنفسه لا يمتلك هذا التبرير لأنه مجرد تجمع عددي للشواهد. فإذا إستطعنا أن نكشف عن رابط يشد هذه القضايا المشمولة بالإستقراء بعضها ببعض ويجعل أحدها (أ على سبيل المثال) سبباً في وجود الآخر (ب) أو أن عدم (أ) سبب لعدم (ب) فإننا نستطيع حينئذ أن نبرر هذا التعميم ونمد جسر الإتصال بين الخاص والعام ونصل في نهاية المطاف إلى العلم الجازم بقضية ما. فكيف إستطاع المنطق الأرسطي أن يجعل من الإستقراء الناقص مفيداً للعلم؟
للإجابة عن هذا السؤال لنفترض أن (أ) دائماً تقترن بـ (ب) في جميع التجارب التي نجريها. هذا الإقتران التزامني بين (أ) و (ب) بمعنى التعاقب الزمني في ظهور (ب) كلما وجد (أ)، لا يكشف عما إذا كانت (أ) و (ب) يرتبطان على النحو الذي يجعل من (أ) سببا في وجود (ب) أو أن عدمها عدم لـ (ب) أو لا. فقد يكون هذا الإقتران بينهما إتفاقاً أي مصادفة، وهنا نحتاج إلى البرهان الذي ينفي الصدفة بينهما ويؤكد لنا أن هذا الإقتران بين (أ) و (ب) في عدد كبير من التجارب ليس صدفة وإنما يعبر عن علاقة سببية وجودية بينهما، ذلك لأن نفي الصدفة نفي لعدم اللزوم، وهو يعني في المقابل أن هذا الإقتران يعبر عن حقيقة وجودية لزومية بحيث يلزم من وجود (أ) وجود (ب). و لنفي الصدفة إفترض المنطق الأرسطي قضية عقلية قبلية مفادها أن الإتفاق لا يكون دائمياً أو أكثرياً “بمعنى أن الإقتران بين (أ) و (ب) في عدد كاف من التجارب لا يمكن أن يكون إتفاقاً” ، فالعقل يدرك بشكل مستقل أن هذا غير ممكن.

وبهذا ينقلب الإستقراء الناقص قياساً إذ يتألف كبراه من هذه القضية العقلية وصغراه من هذه القضايا التي شملها الإستقراء. فاقتران تمدد الحديد بالحرارة يمكن أن يرتب على النحو المنطقي التالي: ما دام الإتفاق لا يكون دائميا أو أكثرياً وما دام (أ) إقترن بـ (ب) في عدد كاف من التجارب فهذا يعني أن (أ) و (ب) لم يقترنا مصادفة بل إن بينهما في العمق رباط من السببية. فإذا توفرت الشروط الموضوعية المناسبة فإن (أ) تكون دائماً سبباً في تولد (ب).
إذن مما سبق يتضح أن المشكلة الإستقرائية تكمن في كون الإستقراء وحده غير قادر على الوصول إلى الحقائق على نحو مستقل، ذلك لأن الإستقراء هو مجرد تجميع عددي للحوادث وهي بدون الإستعانة بالمعارف العقلية القبلية تصبح حوادث جزئية معزولة ليس بينها رابط.
لقد عرفنا أن الإستقراء يواجه ثلاث مشكلات و نلخصها فيما يلي:
أولا: عجزه عن إثبات السببية كظاهرة، فبدون الإيمان المسبق بهذه البديهية العقلية تكون الصدفة هي التي تحكم الحوادث.
ثانياً: عجزه عن إثبات السببية الخاصة، أي أن الحرارة هي سبب تمدد الحديد أو أن الجاذبية هي السبب في سقوط الأجسام بإتجاه الأرض. بمعنى أن الإستقراء بوصفه تجميع عددي للحوادث لا يكشف عن أسباب خاصة مسؤولة في توليد تلك الحوادث.
ثالثاً: عجزه عن إثبات أن هذه العلاقة بين السبب والمسبب هي علاقة تتصف بالإطراد والإستمرارية خارج نطاق التجربة وفي المستقبل.
 هذه هي المشاكل التي تواجه الدليل الإستقرائي والتي يفقد معها إستقلالية الوصول إلى الحقائق. ولقد تغلب المنطق الأرسطي على هذه المشاكل الثلاث بالإستعانة بالقضايا العقلية. فقد تمكن من التغلب على المشكلة الأولى والثانية بالرجوع إلى المعارف العقلية القبلية، فالإيمان بالسببية كمبدأ عقلي أولي فوق التجربة وباعتباره قانون عام يتحكم في كل ظواهر الكون الطبيعية والإجتماعية والسياسية والإقتصادية والتاريخية. كما أنه بالرجوع إلى المبدأ والذي يمكن البرهنة عليه من مبدأ السببية والقائل ” أن القضايا المتشابهة تؤدي إلى نتائج متماثلة ” يمكن التغلب على المشكلة الثالثة. فالمسببات تتبع أسبابها على الدوام إذا توفرت الشروط الموضوعية لذلك.
هذه هي المشاكل التي تواجه الدليل الإستقرائي والتي يفقد معها إستقلالية الوصول إلى الحقائق. ولقد تغلب المنطق الأرسطي على هذه المشاكل الثلاث بالإستعانة بالقضايا العقلية. فقد تمكن من التغلب على المشكلة الأولى والثانية بالرجوع إلى المعارف العقلية القبلية، فالإيمان بالسببية كمبدأ عقلي أولي فوق التجربة وباعتباره قانون عام يتحكم في كل ظواهر الكون الطبيعية والإجتماعية والسياسية والإقتصادية والتاريخية. كما أنه بالرجوع إلى المبدأ والذي يمكن البرهنة عليه من مبدأ السببية والقائل ” أن القضايا المتشابهة تؤدي إلى نتائج متماثلة ” يمكن التغلب على المشكلة الثالثة. فالمسببات تتبع أسبابها على الدوام إذا توفرت الشروط الموضوعية لذلك.
أما المشكلة الثانية، التي يعجز فيها الإستقراء عن إثبات أن هناك سبباً كـ (أ) و ليس (ج) أو (د) أو (هـ) مثلاً هو المسؤول عن وجود (ب)، فقد تغلب عليها بافتراض القضية العقلية التي تنفي الصدفة أو الإتفاق في التجارب المتكررة والتي دائماً تؤكد سببية (أ) لـ ( ب). ” فالإتفاق لا يكون دائمياً ” فابفتراض هذه القضية العقلية يتخلص الإستقراء من مشكلاته المنطقية جميعاً وتصبح التعميمات الإستقرائية لها مبرراتها المنطقية.
الموقف الصدري من المبررات الأرسطيه
 إذا كانت (أ) و (ب) تربطهما علاقة سببية في الواقع على النحو الذي تكون فيه (أ) سبباً في وجود (ب). فإن المبدأ الأرسطي حينئذ ينفي أن تتكرر (ت) أو (ج) أو (هـ) أو أية ظاهرة أخرى لا تؤثر في وجود (ب) في عدد معين من التجارب. وإن كان هذا المبدأ لا يحدد لنا ذلك العدد من التجارب فهو بشكل مطلق ينفي بروز هذه الظواهر وتكررها في التجارب على الخط الطويل. فإذا كنا لا نستطيع مثلاً أن نحدد ما إذا كانت (أ) أو (ت) هي السبب في وجود (ب) فإننا سنشاهد بعد أن نرى عدداً معقولاً من التجارب أن (ت) لا تتكرر في هذا العدد، فإذا إفترضنا أن عدد التجارب عشرة وتتكرر (ت) في تسع منها، يتضح لنا بشكل قطعي أن (ت) غير مسؤولة عن وجود (ب). و لكن ماذا يقصد أرسطو عندما يفترض أن هذا المبدأ يشكل معرفة عقلية قبلية؟
إذا كانت (أ) و (ب) تربطهما علاقة سببية في الواقع على النحو الذي تكون فيه (أ) سبباً في وجود (ب). فإن المبدأ الأرسطي حينئذ ينفي أن تتكرر (ت) أو (ج) أو (هـ) أو أية ظاهرة أخرى لا تؤثر في وجود (ب) في عدد معين من التجارب. وإن كان هذا المبدأ لا يحدد لنا ذلك العدد من التجارب فهو بشكل مطلق ينفي بروز هذه الظواهر وتكررها في التجارب على الخط الطويل. فإذا كنا لا نستطيع مثلاً أن نحدد ما إذا كانت (أ) أو (ت) هي السبب في وجود (ب) فإننا سنشاهد بعد أن نرى عدداً معقولاً من التجارب أن (ت) لا تتكرر في هذا العدد، فإذا إفترضنا أن عدد التجارب عشرة وتتكرر (ت) في تسع منها، يتضح لنا بشكل قطعي أن (ت) غير مسؤولة عن وجود (ب). و لكن ماذا يقصد أرسطو عندما يفترض أن هذا المبدأ يشكل معرفة عقلية قبلية؟
إنه يقصد أن هذا المبدأ يتساوى من حيث الضرورة والقيمة المعرفية مع مبدأ عدم التناقض مثلاً، فإذا كان من المستحيل عقلاً وواقعاً أن تجتمع الأضداد في الزمان والمكان الواحد فإن تكرر الصدفة في التجارب يساويه في الإستحالة العقلية. بمعنى أن إستحالة إجتماع النقيضين وإستحالة تكرار الصدفة يعبران عن ضرورة معرفية سابقة عن التجربة، ففي الوقت الذي لا نستطيع أن نتصور عالماً تعيش فيه الأشياء مع أضدادها فأنه كذلك لا نستطيع أن نتصور أن تتكرر الصدفة على الخط الطويل في التجارب.

لم يقبل السيد الصدر التبرير الأرسطي الذي يرتكز على نفي تكرار الصدفة – النسبية – في عدد محدد من التجارب بمعنى أن ” الإتفاق لا يكون دائميا أو أكثرياً ” باعتبارها قضية عقلية قبلية. ولقد شكل بموقفه الرافض لهذا التبرير حداً زمنيا يفصل بين مرحلتين من تطور نظرية المعرفة على ضوء المذهب العقلي. لقد كان هذا التبرير الأرسطي مقبولا ً لكل الفلاسفة المسلمين باعتبار هذه القضية – المبدأ الأرسطي – يدركها العقل كضرورة قبل التجربة. لكن السيد الصدر رضوان الله عليه بمثل عبقريته النادرة وجه إعتراضات سبعة تنسف كون عدم تكرار الصدفة – النسبية – في التجارب مبدأ عقلياً قبلياً وبالتالي تنسف المرتكز الأساس الذي يعطي للتعميم في الإستقراء الناقص مبرراته المنطقية.
ترتكز البراهين الصدرية في نفي المبدأ الأرسطي على ما يلي:
1. إن المبدأ الأرسطي بافتراضه هذا المبدأ إنما يلتقي وتفسيره للمعرفة على ضوء المذهب العقلي.
فالمذهب العقلي يؤمن أن المعرفة البشرية تستند إلى المعارف العقلية الأولية المستقلة عن الحس والتجربة والتي تشكل الأساس الذي تنمو على ضوئها المعرفة. ولذلك فإن هذا المذهب يقسم المعارف البشرية إلى معارف عقلية قبلية أولية بمعنى أن يكون ثبوت المحمول للموضوع ضرورياً. ونقصد بهذه الضرورة الضرورة الذاتية التي تستلزم عقلاً إستحالة التفكيك أو الفصل بين المحمول والموضوع. ومعارف نظرية تحصل عن طريق البرهان المبني على أساس المعارف الأولية. بحيث يكون ثبوت الموضوع للمحمول عن طريق الحد الأوسط الذي يشكل السبب الرابط بينهما (المحمول والموضوع).
2. إن الصدفة التي ينفيها المبدأ الأرسطي ليست الصدفة المطلقة وإنما الصدفة النسبية.
فالصدفة المطلقة تعني حدوث شيء بدون أي سبب على الإطلاق وهذا مستحيل لأنها تتعارض مع مبدأ السببية. أما الصدفة النسبية التي يتحدث عنها المبدأ الأرسطي فهي ليست مستحيلة ويقصد بها أن تقترن – مثلاً – الظاهرة (أ) بالظاهرة (ب) إتفاقاً وليس على أساس وجود علاقة سببية بينهما. فقد يقترن على سبيل المثال ظاهرة تمدد الحديد بسماع صوت.
3. عندما يقرر المبدأ الأرسطي أن الصدفة لا تتكرر باستمرار على المدى الطويل إنما يقصد بالمدى العدد المعقول من التجارب 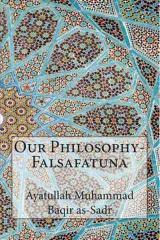 والتي لا يمكن للصدفة أن تتكرر فيها جميعاً. لكن المبدأ الأرسطي لا يحدد لنا ذلك العدد الذي يستحيل بحسب فرضه أن تتكرر فيه الصدفة إن كانت العلاقة القائمة في التجارب، بين (أ) و (ب) مثلاً، علاقة سببية في الواقع. وكذلك لا يستطيع أن يعين لنا نوعيتها وفي أي منها ستتكرر هذه الصدفة لأن ذلك يتطلب معرفة تامة بالظروف الكفيلة بظهورها وهذا غير ممكن. إذن المبدأ الأرسطي في حقيقته هو علم ينفي شيئاً لا يمكن تحديد طبيعته وعدده وزمان ظهوره فهو علم بالنفي وحسب.
والتي لا يمكن للصدفة أن تتكرر فيها جميعاً. لكن المبدأ الأرسطي لا يحدد لنا ذلك العدد الذي يستحيل بحسب فرضه أن تتكرر فيه الصدفة إن كانت العلاقة القائمة في التجارب، بين (أ) و (ب) مثلاً، علاقة سببية في الواقع. وكذلك لا يستطيع أن يعين لنا نوعيتها وفي أي منها ستتكرر هذه الصدفة لأن ذلك يتطلب معرفة تامة بالظروف الكفيلة بظهورها وهذا غير ممكن. إذن المبدأ الأرسطي في حقيقته هو علم ينفي شيئاً لا يمكن تحديد طبيعته وعدده وزمان ظهوره فهو علم بالنفي وحسب.
ويطلق على العلم بالنفي الغير محدد بالعلم الإجمالي (وهو الذي وظفه السيد الصدر لاحقاً في تعريف الإحتمال). وتقوم الإعتراضات على نفي كون هذا المبدأ يشكل علماً إجماليا عقلياً قبلياً. وسنتعرض لهذه الإعتراضات السبعة في مقالة أخرى إن شاء الله تعالى.
 علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية
علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية
