الحقيقة تلك الجوهرة الضائعة التي يبحث عنها البشر في محيط متلاطمٍ من الكذب والتضليل. الحقيقة التي يدّعي كلّ انسانٍ أنّه يملكها، او هكذا يظن، لينام مستريح البال. الحقيقة التي يختلف عليها البشر فتشن الحروب ويقتل الأبرياء وتزهق الأرواح.
هل يمكن أن يعرف الإنسان الحقيقة؟
وكيف؟
ولماذا يختلف البشر عليها؟

ما هي الحقيقة: ليس للحياة معنى إن لم توجد الحقيقة، فما هي الحقيقة؟
التعريف الأول: الحقيقة هي مطابقة الفكرة الذهنية للواقع الخارجي
هذا التعريف ينطبق حين نلاحظ مطابقة أفكارنا او عدم مطابقتها للواقع الخارجي، فهل نملك صورةً ذهنيةً صادقةً مطابقة 100% للواقع الخارجي، أو أن صورتنا الذهنية تختلف تمامًا او نسبيًا عن الواقع الخارجي؟ لكن ما المهم في هذا؟
الأفكار في أذهاننا تخلق المشاعر والعواطف في نفوسنا وهي بدورها تحدد الأفعال والسلوك الذي نقوم به. لذا فحين تكون أفكارنا مطابقة للواقع الخارجي، تكون مشاعرنا وعواطفنا متناسبة مع الواقع الخارجي وبناءً عليها يصدر منا الفعل والسلوك المناسب.
مثال: لو أخبرك شخصٌ أنّ هناك ذئبٌ مفترسٌ يقترب منك، فستشعر بالخوف وستبحث عن مكانٍ آمن. فإن كان الفكرة صحيحة أي أنّ الحيوان المقترب هو ذئبٌ مفترسٌ، فإنّ شعورك بالخوف وهروبك الى مكانٍ آمن يعتبر مناسبًا وصحيحًا. لكن لو كانت فكرة أن هناك ذئبٌ مفترسٌ يقترب منك خطأ وليست صحيحة، فالواقع الحقيقي الخارجي هو أنّه كلبٌ اليف وليس ذئبًا، فسيكون شعورك بالخوف وهروبك عملٌ غير مناسب وغير سليم.
الخطر الكبير الذي يداهم الحقيقة بناءً على هذا التعريف هو الكذب والتدليس، فحين يريد شخصٌ أن يخفي الحقيقة، كلّ ما عليه أن يشوّش الواقع الخارجي بحيث يراه الآخرون بصورةٍ مغايرةٍ للحقيقة فتكون مشاعرهم وأفعالهم مغلوطة لا تتناسب مع الواقع الخارجي الحقيقي.
وهنا يتبين دور الكذب الخطير في الإعلام الذي يعصف بالحقيقة في عالمنا المعاصر. فرغم أنّ الكذب من الأمور المحرمة انسانيًا لأنه ينسف المصداقية ويحرف الاستقامة التي هي أساس التعامل الإنساني، لكنّ الفكر الغربي (البراغماتية) برّر الكذب، فالبراغماتية لا ترى أنّ الحقيقة مطلقة، بل كلّ فعلٍ يحقق نتيجةً عمليةً مرغوبة يعتبر صحيحًا، فحين يحقق الكذب نتيجةً عمليةً مرغوبةً للفاعل، فهو عمل إيجابي.
وهكذا ضاعت المصداقية والاستقامة وأضحت الحقيقة لعبةً يتداولها بعض الغربيين كلٌ حسب هواه ورغبته.
الخطير في الأمر أنّ الإعلام سلاحٌ فتّاكٌ يملكه الأقوياء عسكريًا واقتصاديًا، فحين لا يتورعون عن الكذب بل يستخدمون أحدث تقنيات الإنفو- ميديا في نقل الخبر وتلفيق الصورة وصناعة الفيلم ، ويكررون ذلك عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، تنطلي وتضيع الحقيقة ومعها يضيع حقّ الآخرين.

والسؤال هو ما ذنب ملايين البشر الذين يتعرضون لهذا الهدير الإعلامي الكاذب حين يصدقون الصورة الكاذبة والرواية المزيفة فيصبح الضحية لديهم مجرمًا، فيشعرون بالغضب من هذه الضحية ويتخذون منها موقفًا سلبيًا؟ وكيف يمكن لهم أن يتبينوا الحقيقة في هذا الركام من الكذب والأضاليل؟ هذه ليست مشكلة التفكير السليم، بل هي مشكلة التغذية الفكرية بالإعلام الكاذب.
إنها المشكلة التي بدأت مع الإنسان منذ بداية الخليقة وحتى عصرنا الحاضر، فالهمجي يريد أن يصنع له واقعًا مزيفًا كاذبًا يتناسب مع مصالحه وأهوائه، لذا نعتت بعض الأمم الأنبياء والرسل سابقًا بالكهانة والسحر.
وهنا تأتي أهمية المصداقية والاستقامة لأصحاب الحقيقة، فالكذب محرّمٌ هزله وجدّه، بل هو أساس كلّ زيفٍ وتضليلٍ وتحريفٍ للحقيقة.
التعريف الثاني: الحقيقة هي ما يجب أن تكون عليه الأشياء
هذا التعريف يختلف عن التعريف السابق، فهو يرى أنّ الحقيقة هي ما تنادي به القيم الأخلاقية والعدالة الإنسانية وليس بالضرورة ما يتوافق مع الواقع الخارجي بل قد تختلف عنه تمامًا.
خذ مثلًا، حين أستعبد الغربيون بعض الأفارقة وجلبوهم الى أوروبا وأمريكا لخدمة السيد الأبيض ومارسوا ضدهم أدهى أشكال العنصرية حتى أصبح الواقع الخارجي في أمريكا واوروبا عنصريًا، ففصلوا البيض عن السود في السكن والطعام وجعلوهم خدمًا وعبيدًا لقرونٍ طويلة. فلو وُلِدَ أمريكي في هذه البيئة العنصرية، فما هي الحقيقة بالنسبة له؟ هل سيتخذ الواقع العنصري المعاش حقيقةً مقبولة، أم أنه سيرى أنّ الحقيقة هي ما يجب أن تكون عليه الأشياء وهي العدالة والمساواة في الفرص والحقوق وليس الاستعباد والعنصرية؟
لكنّ البعض يسأل: طالما تغنّى الغرب بأنّ الحقيقة هي الإنسانية والحرية والكرامة، فلماذا إذن بقيت لديهم العبودية والفصل العنصري قرونًا طويلةً؟
الغرب على ثقافاتٍ مختلفة، فمنهم من يرى أنّه شعب الله المختار، بينما بقية البشر في نظره هم في الدرجة الثانية والثالثة و دونهما، فمن الطبيعي أن تكون الحقيقة لديه عنصريةً بغيضةً تدفعه للكذب على غيره و إذا دعت الضرورة قتلهم وتدميرهم دون أدنى شعورٍ بالذنب والخطيئة. هؤلاء يتعاملون مع بقية البشر بفوقية متعالية ويعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم الأفضل علميًا وتقنيًا وانسانيًا. الغريب أنّ منهم المفكرون والكتّاب، فمنهم مثلًا:
المؤلف (Niall Ferguson) في كتابه (Civilization) حيث يذكر في صفحة 235:
“The Jewish role in Western intellectual life in the twentieth century – especially in the United States- was indeed disproportionate, suggesting a genetic as much as a cultural advantage”
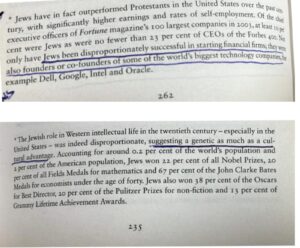
ويذكر في صفحة 262 من نفس الكتاب:
”Not only have Jews been disproportionately successful in starting financial firms; they were also founders and co-founders of the world’s biggest technology companies”
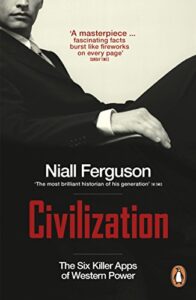
هذا مثالٌ صارخٌ، يصرّح هنا بان ّ جيناتهم أفضل من غيرهم، فهي السبب في تفوقهم العلمي والتقني والاقتصادي!!
الخطر الكبير أنه حين يصل هؤلاء الى صناعة القرار، فيمتلكون وسائل القوة كالإعلام والاقتصاد، لا يتورعون عن ممارسة أقسى وأبشع أنواع القتل والتدمير بغيرهم تحت وابلٍ من الكذب والتزييف الذي تنشره آلتهم الإعلامية الكاذبة، حيث يصورون أنفسهم بأنهم الضحايا المظلومون ليغطوا جرائمهم المروعة في حقوق الآخرين.
البقية في الغرب عاش تاريخيًا قبل ثلاثمائة عام في أمريكا وقبل خمسمائة عام في أوروبا، في تنافسٍ محمومٍ على المصلحة المادية التي نادت بها الرأسمالية، وتحت فائضٍ من القوة العسكرية.
لذا فقد مارس الغربي الأبيض القتل والتنكيل بالسكان الأصليين في أمريكا واستراليا وأستعبد البشر من أفريقيا، ونهب مواردهم الطبيعية وسعى لتدمير ثقافتهم الأصلية حفاظًا على مصالحه الحيوية وبعيدًا عن القيم الأخلاقية والعدالة الإنسانية.

وحتى يجعل ذلك حقيقةً مقبولة لدى الآخرين أدّعى زيفًا وخداعًا أنه أستعمر الآخرين ليطوّرهم اقتصاديًا وعلميًا، و لايزال يمارس نفس التضليل الآن بمسميات مختلفة، فتحت عنوان صراع الحضارات يحذر مفكروهم من الإسلامو- فوبيا وأنّ حضارتهم الغربية مهددة بغولٍ إسلامي يتسلّل إليهم عبر الهجرة وغيرها.
وحاليًا يمارس الغرب الهندسة الثقافية عبر نشر أفكارٍ معسولةٍ تنادي بأنّ التقدم والتنمية لا تتحقق إلا عبر التخلي عن القيم الأخلاقية والتحرر من القيود الاجتماعية ومن خلال بهرجة دعائية وإعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي وتلميع شخصياتٍ تافهةٍ يتم نفخها وتنميقها للأجيال الصاعدة بغية غسل أدمغتهم وهندستهم ثقافيًا بما يتناسب وحفظ المصالح والقيم الغربية.
كتاب الفرد وكتاب المجتمع
لسنا من دعاة التنميط والتعميم فهناك الكثير من العلوم والأفكار الغربية التي تستحق التقدير والاهتمام، والتي ينبغي أن ينصب عليها اهتمام جيلنا الصاعد. كذلك هنالك الكثير من المفكرين والأفراد الغربيين الذين يختلفون عن الطابع العام الذي يعيشه المجتمع الغربي والذين يستحقون أسمى التقدير والاحترام على مواقفهم الإنسانية.
الكتاب هو سجلّ الأعمال الذي ينبغي ان يحاسب عليه الفرد والمجتمع. فالفرد قد يتوافق مع المجتمع فكرًا وشعورًا وسلوكًا فيكون كتابه مشابهًا لكتاب المجتمع، وقد يختلف الفرد عن المجتمع فيكون كتابه مختلفًا ايضًا. لذا يجب أن نميز بين الفرد الغربي والمجتمع الغربي. فالفرد مهما كان عادلًا في فعله وسلوكه، فاضلًا في أخلاقه وقيمه، يبقى تأثيره في حدودٍ ضيقةٍ مالم يكن فاعلًا ومؤثرًا في توجيه مجتمعه.
إنّ ما حدث في العالم الغربي، هو أنّ الرأسمالية سمحت بتغول أصحاب الثروة فملكوا الشركات والإعلام ووسائل التأثير الاجتماعي، فاختطفوا قرار المجتمع ووجهوا ثقافة الفرد واهتماماته اليومية بما يتناسب وتحقيق مصالحهم المادية. لذا أصبح الفرد غالبًا آلة استهلاكية يعمل ويستهلك ويردّد ما يدور في وسائل الإعلام من انقاذ قطة على شجرة او مباراة بيس بول وغيرها.
نعم، بقي هنالك البعض من المفكرين وأصحاب الضمير ولكنّهم يعانون من تغول الإعلام المزيف وطمع الشركات الجشع. هؤلاء الأفراد قد يكون كتابهم ناصعًا يستحق كلّ التقدير والاحترام، لكنّهم يعيشون في مجتمعٍ قد لوّث كتابه الجمعي بأفعالٍ تاريخية وعصرية يندى لها جبين الإنسانية.
الحقيقة الضائعة
البحث عن الحقيقة في ركام الكذب والتضليل التاريخي والحديث مسؤولية عظيمة يتحملها كلّ انسانٍ مهما كانت ثقته عالية ونفسه مطمئنة بأفكاره وقيمه، فمزيدٌ من البحث يدعو الى مزيدٍ من الثقة والاطمئنان. نعم، فالبحث عن الحقيقة نورٌ ساطعٌ يسلطّه الإنسان بكلّ تجرد وموضوعية ليرى طريقه في ظلمات التاريخ والإعلام الكاذب. هذا لا يقتصر على الغرب دون الشرق، بل الجميع في أقصى الحاجة للبحث عن الحقيقة.
قد نشعر بالشفقة على من يتعرض الى وابلٍ من التضليل الإعلامي فيتخذ موقفًا مشينًا في عواطفه وأفعاله، إلّا أنّ هذا لن يبرّر عمله ولن يحقّق له السعادة في دنياه وآخرته، فالحقيقة المطابقة للواقع الخارجي والمبنية على القيم الأخلاقية والعدالة الإنسانية جوهرة ثمينة تستحق من البشر مزيدًا من البحث والتدقيق، والحمد لله ربّ العالمين.

 علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية
علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية

احسنت اخي العزيز ابو محمد وهذا ما نراة اليوم سواء في الوسائل المرئية والمسموعة و مواقف الدول والهيئات الدولية في قلب الحقائق والكذب الممنهج وغسل الادمغة والشيطنة والله المستعان واعان الله الاجيال الحالية والقادمة
نداء قيم للتفكر و التمحيص حتى تتبين الحقيقه الناصعه التي تخدم الإنسان في مسيرته بحيث تكون مشاعره و عواطفه مطابقه للواقع المعاش الذي لا غبار عليه و منها تنعكس إيجاباً على سلوكياته و أفعاله. البشر يفتنون و يختبرون في مسيرتهم الحضاريه مما يستلزم و جود أطر و قواعد و أساسيات (مكارم أخلاق) تحكم التفكير بحيث تكون التفاعلات حقيقيه و منها تكون الأفعال و التصرفات مناسبه و مؤثره بصوره سليمه في الواقع المعاش.
شكراً للكاتب و تقبل تحياتي
مقالة رائعة اخي العزيز د. بو محمد،
للأسف الإعلام يبيعنا ما يريد وينمّط عقولنا وأفكارنا لخدمة المتحكمين بوسائل الإعلام. إضف الى ذلك أن هناك من يختار أن يصدق ما وافق هواه ومعتقده وقد يفضّل العيش في الوهم على أن يواجه ارثه الحضاري والعقدي.
أحسنت دكتور… تستحق ان تلقى في محاضره.
الشكر لكم على تفضلكم بقراءة المقالة و تعليقاتكم الرائعة.
كنت اظن ان التقنية الحديثة تسهل الوصول الى الحقيقة لكن الواقع اثبت عكس ذلك و هاهو الذكاء الاصطناعي و الفوتو شوب تكاد تصنع صورًا مفبركة يصعب اكتشافها.
و يبقى الإنسان باحثًا عن الحقيقة. إنه نهم لا يهدأ ابدًا.